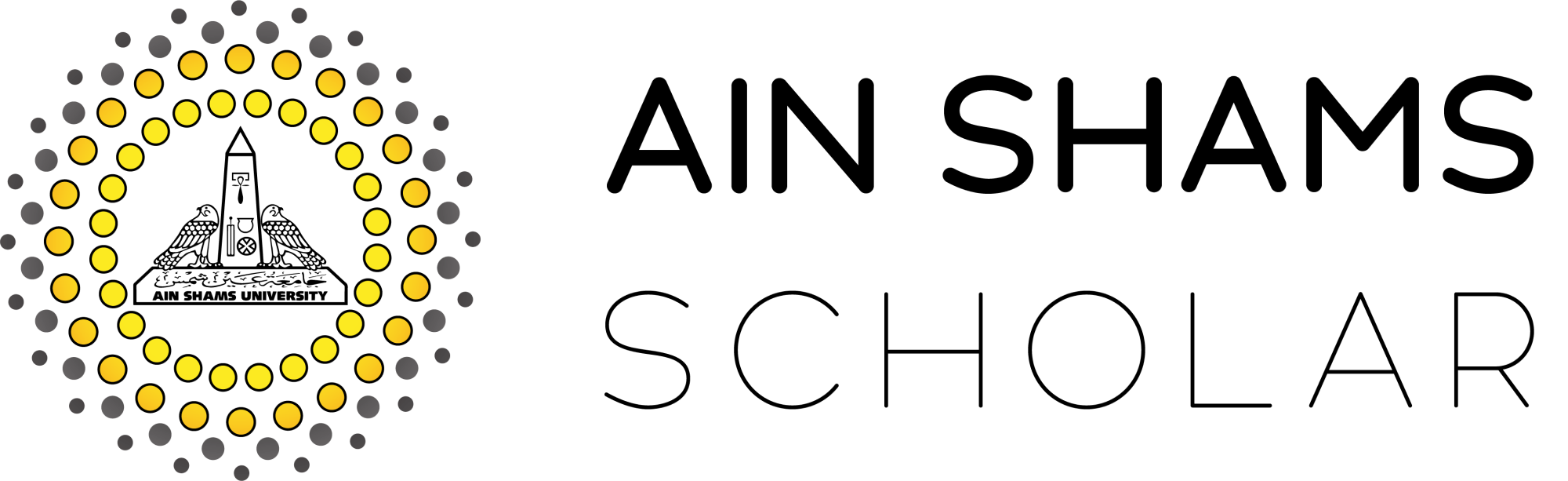المتغيرات المحددة للتنشئة الاجتماعية في فكر «الإمام أبو حامد الغزالي» من منظور علم الاجتماع التربوي دراسة تحليلية سوسيولوجية
راقية محمد سمير سيد على النمر;
Abstract
إن سلامة المجتمع وقوة بنيانه ومدى تقدمه وإزدهاره وتماسكه مرتبط بسلامة الصحة النفسية والاجتماعية والأخلاقية لأفراده، فالفرد داخل المجتمع هو الأساس الذي يبنى على عاتقه المستقبل، وهو المحور، والمركز والهدف والغاية المنشودة، أما ما حول هذا الفرد من إنجازات وتخطيطات، ليست أكثر من تقدير لمدى فعالية هذاالفرد. التنشئة الاجتماعية قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، مارستها الأسرة، والعشيرة، والقبيلة، لتنشئ أطفالها ولتحافظ علىاستمرارية عاداتها وتقاليدها، وأما دراسة عملية التنشئة، فهي حديثة، بدأ الاهتمام بها في أواخر الثلاثينات، وأوائل الأربعينات من القرن العشرين؛ وذلك عندما نشر «بارك» «Bark» «بحثه عن التنشئة كمرجع هام لدراسة المجتمع»( )، وموضوع التنشئة الاجتماعية من الموضوعات التي تأخذ مكانة مركزية في مجال التربية وعلم النفس، إذ يشكل هذا الموضوع نقطة تقاطع علوم مختلفة، أبرزها علم الاجتماع التربوي، وعلم النفس بفروعه المختلفة، ولا سيما علم النفس الاجتماعي، وكلها اهتمت بالتنشئة في وقت واحد، وهذا يعني حاجة التطور العلمي في العلوم الإنسانية إلى هذا المفهوم لتفسر به الظواهر العلمية التي ترتبط بها( ).
فالإنسان كائن اجتماعي يعيش، ويقضي معظم وقته في جماعة، وفي جماعات يؤثر فيها ويتأثر بها، ويتحدد سلوكه الاجتماعي على أساس النمط المصطلح عليه، والفرد منذ ولادته، وخلال نموه تطرأ عليه تغييرات جوهرية تشمل جوانب عديدة من شخصيته، فهو ينمو جسميا، وفسيولوجيا، وينمو عقليا، وينمو انفعاليا، وينمو اجتماعيا، فمنذ طفولة الفرد تنمو لديه القدرة تدريجيا على إنشاء العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، فهو يكتسب الأساليب السلوكية، والاجتماعية، والاتجاهات، والقيم، والمعايير، ويتعلم الأدوار الاجتماعية، وهو يتعلم ما يصطلح عليه بالتفاعل الاجتماعي مع رفاق السن، وينمو أخلاقيا، ودينيا؛ لذلك صار لزاما معرفة دوافع السلوك الاجتماعي، بهدف تحديد علاقة الطفل بباقي رفاقه- رفاق الحي- والمدرسة... بغية فهم السلوك، ووصفه والتنبؤ به، والتحكم فيه... لنخرج بفهم وتفسير لحياتنا وحياة الآخرين، وكذلك توجيه هذه الحياة توجيها صحيحا، فمسألة النشء وتوجيهه لما يسعده في حياته بتحقيق المزيد من الرضا، والتكيف الاجتماعي مع نفسه أولا، ومع بيئته الاجتماعية التي يعيش فيها مسألة جوهرية، وهي ما يتناوله علم الاجتماع التربوي بالبحث والدراسة، والقياس الاجتماعي( ).
ويتفق الفلاسفة، والمربون ورجال الدين، منذ أقدم العصور إلى الآن على أهمية الأخلاق في حياة الفرد والمجتمع والتمسك بالأخلاق الفاضلة والانتهاء عن الأخلاق السيئة( ).
وقد سعت بعض الدراسات الغربية في دراستها لعملية التنشئة الاجتماعية، إلى دراسة المعانى والرموز والصور المتبادلة في مواقف التفاعل الجزئية والمحدودة والتي تتشابك، وتتصاعد لتصبح عمليات، ونظم أبنية اجتماعية، تلك التي تحدث بين شخصين، أو في داخل الجماعة الصغيرة، وتشابهت نظرياتهم في ذلك، كما ان نظرية التبادل التي قدمها «جورج هومانز» «George Humans» و«بيتر بلاو» «Peter Blau» نظرت إلى الذين يتبادلون قيما من خلال تفاعلاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية اليومية، وهذه القيم تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية، أنهم يمتلكون نوعا من الرشد( ).
والحياة الاجتماعية عامة في رأي مثل «جبريل تارد» «Gabriel Tard» وهو مؤسس اتجاه السلوكية الجمعية، والذي هو أقدم الاتجاهات في هذه المدرسة، تعتمد على تفاعل عاملين: «الاختراع، والتقليد»، فالاختراع وهو في جوهره ظاهرة فردية تضمن للمجتمع التجديد والتقدم، والتقليد يضمن للمجتمع الإستمرار، وقد كتب تارد «Tard» في كتابه قوانين التقليد «tradition law» إن المجتمع لا يستطيع أن يعيش ولا أن يتقدم إلى الأمام ولا أن يتطور دون أن يعتمد على ينبوع الروتين والتقليد الذي لا ينضب والذي يتزايد بإستمرار مع تعاقب الأجيال( ).
وأسهمت الدراسات الاجتماعية في دول العالم الثالث في الكشف عن مختلف أشكال القهر الاجتماعي، والثقافي الذي تعرضت لـه مجتمعات تلك الدول في حقبة الهيمنة الاستعمارية، مما أدى إلى تعزيز تخلفها الثقافي والتربوي ويمكن الإشارة هنا إلى كتاب فرانز فانون Franz Fanon»»» «معذبو الأرض» ودراسة ج. كابرال «J.kabral» السلطة والإيديولوجية «Power and Ideology»( ).
وقد بينت بعض الدراسات الصادرة في تلك المجتمعات مسؤولية الأنظمة المدرسية في عهود الاستعمارعن الأمية الواسعة التي خلفتها في تلك المجتمعات بعد استقلالها، وخاصة اقتصار تعليمها على نخب معينة كي تخدم في أجهزتها الإدارية، وكشف باولو فرايري «Paulo Freiri» زيف حملات محو الأمية الرسمية في مجتمعات أمريكا الجنوبية والطابع القهري لمضامين المقررات المعتمدة في تلك الحملات لمحو أمية الفقراء من سكان الأحياء الفقيرة في البرازيل، ودعا إلى «تعليم للكبار» قائم على توعية الدارسين في صفوف محو الأميةلمجتمعاتهم، والتخلص من هامشيتهم الاجتماعية ويتضمن كتابه «تربية المقهورين» «Pedagogy of the Oppressed» وكتاب «التربية من أجل الحرية» «Education for Freedom» إشارات واضحة لتمكين الأميين الكبار من التحرر من دونيتهم الاجتماعية والثقافية( ).
وفي بداية القرن العشرين ظهر ميل لتطوير الحقل المعرفى لهذا الفرع من علم الاجتماع العام نتيجة لتزايد أهمية التعليم، وانتشارمؤسساته في المجتمعات الحديثة، ونتيجة لذلك، ظهرت حتى عام 1914عدة مؤسسات، تقدم مواد تتعلق بعلم الاجتماع التربوي، وفي عام 1932 تم تأسيس، وتنظيم الجمعية الوطنية، لدراسة هذا العلم في بريطانيا، فقامت هذه الجمعية بنشر ثلاث نشرات سنوية بين عامى 1932- 1934، وتوقفت تلك النشرة عن الصدور بعد ذلك( ).
وقد لاحظ «هارنجتون» «Harington»، قلة عدد المواد، التي تدرس في مجال علم الاجتماع التربوي في الفترة بين عامي 1926- 1947، مما حدا به إلى الدعوة إلى الاهتمام بهذا العلم وموضوعاته وقضاياه ولقد أسهمت هذه البوادر الأولى في دفع عجلة قيام هذا العلم، الأمر الذي أدى إلى إزدهاره بعد نهاية الحرب العالمية الثانية( ).
وبالرجوع إلى كتابات بعض رواد علم الاجتماع الذين اهتموا بالتربية، نجد أنه في الخمسينيات من هذا القرن، بدأت تظهر في أوروبا وخاصة في انجلترا، دراسات تعالج التربية، من منظور علم الاجتماع، والذي أدى إلى فهم خطورة التربية في حياة المجتمع، والأفراد، والمواقف العقائدية الأيديولوجية حول وضع التربية، ومفاهيم مثل، تحقيق المساواة في فرص التعليم، إلى جذب علماء اجتماع جدد، لدراسة موضوع التربية، كظاهرة اجتماعية في إطارها الاجتماعي العام( ).
إن التربية الإسلامية على وجه الخصوص تهتم بالأخلاق، وتجعل منها الهدف الأسمى؛ لأنها تهدف إلى تكوين أناس ذوى نفوس أبية، وإرادة قوية، وعزيمة صادقة، يعرفون الواجب ويقومون به، وبالتالى يقرب المجتمع المسلم من الكمال الخلقي المنشود( ).
وذلك لأن الفكر التربوي الإسلامي يستمد أصوله النظرية والتطبيقية من منهجية تكوينية قيمية استلهمها من ينابيع القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة. وقد نجحت التربية الإسلامية في واقع الحياة على رقعة واسعة من الأرض، والمعمورة، وما تزال ينابيعها ثُرَّة خَيِّرة، يمكنها أن تجد التجربة الناجحة وتروى ظمأ الإنسانية، وتحل مشاكلها في كل زمان ومكان، وقد تجلت عناية التربية الإسلامية في تقديم العلم والحث على طلبه، وفي الاهتمام بالفضائل الخلقية والتخفيف من الآثار السلبية، لما قد يترتب على الفروق بين الشعوب والأجناس والطبقات في مجال التعليم، والدين، وإعطاء الأفراد فرصا متساوية في التحصيل، والتي لم تكتمل في كثير من الأمم الحديثة حتى اليوم( ).
فالطابع العام للتربية عند المسلمين لم يكن دينيا محضا، ولم يكن دنيويا محضا، وإنما كان يلائم بين الدين والدنيا مصداقا لقول الله تعالى: ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ [القصص: 77]، ويرى الفكرالإسلامي أن أمر الله تعالى: ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ [العلق: 1] هو البداية الصحيحة والطريقة المثلى، للتنمية الفكرية، والإعلاء من قيمة العقل والبحث العلمي، وتفعيلهما سلوكا حضاريا في واقع الحياة، وذلك لحماية الإنسان من التلوث الفكري، والبيئى، الذي يقضى على فاعليته وكرامته وعزته( ).
ولقد وهب كثير من العلماء حياتهم للعلم، تحصيلا وتدوينا، لا لشئ سوى الإيمان بتحصيل العلم، كما عبر عن ذلك الإمام الغزالي في الإحياء: «إذا نظرت إلى العلم، رأيته لذيذا في نفسه، فيكون مطلوبا لذاته، ووجدته سبيلا إلى الدار الآخرة وسعادتها، وذريعة إلى القرب من الله تعالى، ولا يتوصل إليه إلا به، وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمى السعادة الأبدية، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها، ولن يتوصل إليها، إلا بالعلم والعمل، فأصل السعادة في الدنيا والآخرة، هو العلم»( ).
ومن هنا تعتبر الدراسات التربوية في المجتمعات الإسلامية محورا مهما في أصول التربية الإسلامية، كما أن مثل هذه الدراسات تبرز أهمية دراسة علمائنا المسلمين، ومن العسير، أن نحيط في هذا المجال بالعدد الوفير من أصحاب النظرات التربوية، والمذاهب التعليمية عند المسلمين، مما أوجب علينا، التعرف على قطب كبير كان من أكبر أقطاب التربية وقادتها في العالم الإسلامي( ).
إنه أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ولد سنة (450هـ= 1058م) في الطابران (من أعمال خراسان). فيلسوف ومتصوف، رحل إلى بلدان متعددة، منها: بغداد، والحجاز، وبلاد الشام، ومصر، وأشهرمصنفاته: كتاب إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، والمنقذ من الضلال، وتوفي في بلدته سنة (505هـ= 1111م)( ).
قال ابن عساكر الدمشقي: «أنه أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي قال: أبو حامد الغزالي حجة الإسلام والمسلمين إمام أئمة الدين، من لم ترَ العيون مثله لسانا وبيانا ونطقا وخاطرا وذكاءً وطبعا، شذا طرفا في صباه بطوس من الفقه على الإمام أحمد الراذكاني، ثم قدم نيسابور إلى درس إمام الحرمين في طائفة من الشبان من طوس وجد واجتهد حتى تخرج عن مدة قريبة»( ).
وصار أنظر أهل زمانه في أيام إمام الحرمين «الجويني»، وبعد وفاته، «الجويني»، خرج من نيسابور، وصار إلى المعسكر، واحتل من مجلس نظام الملك محل القبول، وأقبل عليه الصاحب، لعلو درجته، وظهور اسمه وحسن مناظرته، وكان مجلسه محط رحال العلماء، ومقصد الأئمة، فكان للغزالي نصيب من الاحتكاك بالأئمة وملاقاة الخصوم اللد، ومناظرة الفحول وظهر اسمه في الآفاق، حتى أدت الحال به إلى أن رسم للمصير إلى بغداد، للقيام بالتدريس في المدرسة النظامية فصار إليها، وأعجب الكل بتدريسه، ومناظرته، وما لقى مثل نفسه، وصار بعد امامة خراسان، امام العراق وصنف في علم الأصول تصانيف، وجدد المذهب في الفقه، وفي الخلاف، وعلت حشمته ودرجته في بغداد، حتى كان تغلب حشمته الأكابر والأمراء ودار الخلافة، فانقلب الأمر من وجه آخر، وظهر عليه بعد مطالعة للعلوم الدقيقة( ).
وممارسة الكتب المصنفة فيها وسلك طريق التزهد وطرح ما نال من الدرجة والاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة، فخرج عما كان فيه، وقصد بيت الله تعالى، ثم دخل الشام واقام في تلك الديار قريبا من عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظمةوأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إليها مثل (إحياء علوم الدين) والكتب المختصرة منها مثل الأربعين، وغيرها من الرسائل، ثم أخذ في مجاهدة النفس وتغييرالأخلاق وتحسين الشمائل وتهذيب المعاش، فانقلب شيطان الرعونة وطلب الرياسة والجاه والتخلق بالأخلاق الذميمة، إلى سكون النفس وكرم الأخلاق وهداية الخلق، ودعائهم إلى ما يعنيهم من أمر الآخرة، وتبغيض الدنيا، والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية، ثم عاد إلى وطنه، لازما بيته، مشتغلا بالتفكير( )، وحمل إلى نيسابور والأمر خافيا، وتأكد أنه لم يريد طلب الجاه، وكم جاء إليه ممن يشتغلون بالخلاف، فما تأثر به، ولا اشتغل بجواب الطاعنين».
ويقول ابن عساكر الدمشقي «لقد زرته مرارا وما كنت أحدث في نفسي مع ما عهدته في سالف الزمان عليه من الزعارة وايحاش الناس والنظر إليهم بعين الازدراء والاستخفاف بهم كبرا وخيلاء واعتزازا بما رزق من البسطة في النطق والخاطر والعبارة وطلب الجاه والعلو في المنزلة، انه صارعلى الضد وتصفى عن تلك الكدوات، وكنت أظنه متلفع بجلباب التكلف متنمس بما صار إليه، فتحققت بعدالسبر والتنقير أن الأمر على خلاف المظنون، وأن الرجل أفاق بعد الجنون، وحكى لنا في ليال كيفية أحواله من ابتداء ما ظهر له سلوك الكبر، وغلبت الحال عليه بعد تبحره في العلوم واستطالته على الكل بكلامه، والاستعداد الذي خصه الله به في تحصيل أنواع العلوم وتمكنه من البحث والنظر»( ). وفي الحقيقة، إننا لا ننشد إظهار هذا المصلح الكبير، والمفكر العظيم، وإلا، فلن تكفى المئات الأفضل من هذه الدراسة، ولكن ما أسهمه هذا العالم الجليل في مجال العلم أهله ليكون مصلحا اجتماعيا، ورائدا فيلسوفا وفقيها، وصوفيا، وأصوليا، ومربيا، يحكمه إطار محكم من العلم الوافر، والعقل الناضج، والبصيرة الواعية والفكر الراشد، فصارت له الريادة فيها جميعا، وأصبح واحدا من أعلام العرب الموسوعيين المعدودين( ).
غير أنه يبقى سؤال: لماذا الغزالي دون غيره من أجلاء العلماء المملوء تراثنا بهم؟
لم يكن غير أبى حامد الغزالي كمفكر إسلامي واجتماعي، وفيلسوف، وإمام مسلم يستطيع أن يجعل من قضية الأخلاق قضية عقائدية تمس المجتمع، وأن تكون في المقام الأول الأخلاق الدينية إطارا، ومذهبا هي دستور مجتمعنا الإسلامي. لأنه يتحقق في فكر الغزالي شرطا الإيمان، والعمل، ولا إنفصال بينهما في تركيبة الأخلاق الإسلامية، وذلك أنه في الفكر الإسلامي لابد وأن يكون الاعتقاد هو المنظم للسلوك، فليست الأخلاق مجرد سلوك، وإنما السلوك لابد أن يكون مسبوقا بالاعتقاد سواء في ذلك شعائر الدين أو قيم الأخلاق، ففى خلال فترة اعتزاله، وزهده صنف كتابه إحياء علوم الدين، والذي ابتدأ تأليفه في القدس وأتمه بدمشق، وهو يمثل تجربته التي عاشها في تلك الفترة، ويعتبر كتاب الإحياء أحد أهم كتبه على الإطلاق( ).
واتسم منهج الغزالي في التنشئة الاجتماعية بالوسطية، ووقف بآرائه ضد العصبية الدينية والأفكار التكفيرية، حيث أرجع إبتعاد الناس عن طريق الحق والتدين، إلى طريقة الدعوة، التي تبناها أشخاص، يزكون أنفسهم بإظهار فساد غيرهم، وكانت من حكمه الشهيرة في كتاب (إحياء علوم الدين) «إن إنتشار الكفر في العالم يحمل أوزاره متدينون بغَّضوا الله إلى خلقه بسوء صنعهم وسوء كلامهم»، ومن خلال هذه العبارة نستطيع أن نعرف أو نفهم أنه كان في زمن الإمام أفراد متعصبون لأسس الدعوة الإسلامية حتى أنهم بَغضهم الناس وبغضوا الدين لأجلهم»( ).
ويعد الغزالي بحق ظاهرة فكرية، تكاد تكون فريدة في الفكر الإسلامي، وعبقريته هي عبقرية الصدق الأخلاقي، والذي أكد على تربية الفرد في كتابه إحياء علوم الدين؛ لأن الفرد في نظره أساس المجتمع، وصلاح الفرد هو صلاح المجتمع، فالإمام الغزالي هو بحق أول من أقام بناءا أخلاقيا منهجيا في الأخلاق الإسلامية منذ نشأتها وهذا يرجع بالأساس إلى أن هذا المنهج مستمد من القرآن والسنة النبوية( )، وكانت كتبه، ومؤلفاته ومناقشاته، السم القاتل الذي سقاه لمن يريدون أن يضيعوا المجتمع الإسلامي، وفي عصرنا تزداد المادية ضراوة ويظهر الغزالي من جديد، بكتبه ومؤلفاته، لإيقاف ذلك الغزو المتعدد الجوانب ليعيد القافلة الإسلامية، بإذن الله إلى مسارها الصحيح، وهل هناك أصدق على تصدى الغزالي للمادية اليوم، من الإقبال المنقطع النظير، على مؤلفاته في عالمنا الإسلامي المعاصر، إما بالدراسة والتعليق من المؤلفين، وإما بالقراءة، برغم بعد المسافة الزمنية بيننا وبين الغزالي( )؟!
وهذا يرجع أيضا بالأساس إلى عقيدة الإسلام الذي هو لكل زمان ومكان ويمكن ملاحظة أن الغزالي قد لقب بحجته؛ لشدة فهمه لهذا الدين القيم، وهذا ما تفتقده مجتمعاتنا في كثير من علمائها، الفهم الصحيح، والإخلاص لله، ولدين الله . فالغزالي كان بإجماع علماء المسلمين من السنة أحد كبار أئمة الإسلام( ).
ودراسة فكره التربوي تعد تنقية لبعض الأصول الفكرية التربوية في تراثنا بما يتلاءم مع ظروف المجتمع وليس برغبة في تكرارماكتب عنهم، وهذه سمة من سمات أي مشتغل من المشتغلين بالعمل العلمي في أي مجال من مجالاته؛ ولأن الغزالي هوحجة الإسلام والمسلمين، إمام أئمة الدين. وترى الباحثة أن هنا سؤال يجب طرحه: لماذا عندما نعود إلى ما يتمتع به تراثنا (وخاصة من الفكر الإسلامي) من الثراء الفكري نتهم بالتخلف وحب العودة إلى الخلف، وعدم التجديد والإبداع، أم أنه غزوفكري اجتماعي نفسي، مقصود منه عدم دراسة أفكار ونظريات هؤلاء العلماء الأجلاء، لمعرفة مسبقة من أعداء تطورنا، بقدر هذه الأفكار؟
ويلاحظ أن الغرب يتمسك جيدا بتراثه الفكري والنظري، بل ويحاول فرضه بصورة أو بأخرى برغم ما يعتريه من انتقادات وعجزعن فهم نظم الحياة وأصلها، وافتقاده للنظرة الشاملة، ورغم ذلك ندرس نظرياته بصورة أساسية، ولم تقصد الباحثة هنا أن تمحق هذه النظريات، ولكن، ما أرادت قوله، أن مؤسس علم العمران هو: العلامة عبد الرحمن ابن خلدون العالم العربي الإسلامي، وقد قال (جومبلوفيتش) الذي يعد من آباء علماء الاجتماع في ألمانيا أن ابن خلدون يمكن أن يعد مفكرًا عصريًا بكل معنى الكلمة من وجوه عدة... إنه درس الحوادث الاجتماعية بعمق هادئ رزين، وأبدى آراء عميقة جدًا، ليس قبل «كونت» فحسب بل قبل «فيكو» أيضا كما قال: (استفانو تولوزيو) الإيطالي «ليس لأحد أن ينكرأن ابن خلدون اكتشف حقائق كثيرة في علم الاجتماع( ) وغيره من العلماء المسلمين كثر في الاصلاح الاجتماعي، والتربية، والتنشئة الاجتماعية، ونحن أولى بالتمسك بدراسة تراث علمائنا، وبوضع النظريات الشاملة للمجتمعات.
هذا وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى ستة فصول، تناولت الباحثة في الفصل الأول: قضية البحث، وأهمية الدراسة، وأهدافها، تساؤلات البحث، تعريف المفاهيم المستخدمة، ثم وضع الإطار التحليلي للبحث. والفصل الثاني: وقد اشتمل على: الدراسات السابقة وانقسمت إلى: دراسات عن إسهام الإمام أبو حامد الغزالي في التربية، ودراسات عن التنشئة الاجتماعية، وموقع الدراسة الحالية على خريطة هذه الدراسات. والفصل الثالث، وقد اشتمل على: السياق الاجتماعي والثقافي للإمام أبو حامد الغزالي، حياته وما اشتمل عليه اجتماعيا وفكريا، ثم آراء بعض النقاد في الإمام، والفصل الرابع تحدث عن: علم الاجتماع التربوي ودراسة التنشئة الاجتماعية، وموقف النظريات الكلية، والجزئية فيهما، وموقف نظريات التربية أيضا من التنشئة الاجتماعية، وجاء الفصل الخامس وتحدث عن: الأهداف التربوية عند الغزالي، ومضامين التنشئة الاجتماعية في فكر الإمام، وقواعد وآليات التنشئة الاجتماعية عنده. والفصل السادس احتوى على: مناقشة النتائج في ضوء التساؤلات، ثموضع سياسة اجتماعية لإنجاز التنشئة الاجتماعية من وجهة الغزالي.
فالإنسان كائن اجتماعي يعيش، ويقضي معظم وقته في جماعة، وفي جماعات يؤثر فيها ويتأثر بها، ويتحدد سلوكه الاجتماعي على أساس النمط المصطلح عليه، والفرد منذ ولادته، وخلال نموه تطرأ عليه تغييرات جوهرية تشمل جوانب عديدة من شخصيته، فهو ينمو جسميا، وفسيولوجيا، وينمو عقليا، وينمو انفعاليا، وينمو اجتماعيا، فمنذ طفولة الفرد تنمو لديه القدرة تدريجيا على إنشاء العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، فهو يكتسب الأساليب السلوكية، والاجتماعية، والاتجاهات، والقيم، والمعايير، ويتعلم الأدوار الاجتماعية، وهو يتعلم ما يصطلح عليه بالتفاعل الاجتماعي مع رفاق السن، وينمو أخلاقيا، ودينيا؛ لذلك صار لزاما معرفة دوافع السلوك الاجتماعي، بهدف تحديد علاقة الطفل بباقي رفاقه- رفاق الحي- والمدرسة... بغية فهم السلوك، ووصفه والتنبؤ به، والتحكم فيه... لنخرج بفهم وتفسير لحياتنا وحياة الآخرين، وكذلك توجيه هذه الحياة توجيها صحيحا، فمسألة النشء وتوجيهه لما يسعده في حياته بتحقيق المزيد من الرضا، والتكيف الاجتماعي مع نفسه أولا، ومع بيئته الاجتماعية التي يعيش فيها مسألة جوهرية، وهي ما يتناوله علم الاجتماع التربوي بالبحث والدراسة، والقياس الاجتماعي( ).
ويتفق الفلاسفة، والمربون ورجال الدين، منذ أقدم العصور إلى الآن على أهمية الأخلاق في حياة الفرد والمجتمع والتمسك بالأخلاق الفاضلة والانتهاء عن الأخلاق السيئة( ).
وقد سعت بعض الدراسات الغربية في دراستها لعملية التنشئة الاجتماعية، إلى دراسة المعانى والرموز والصور المتبادلة في مواقف التفاعل الجزئية والمحدودة والتي تتشابك، وتتصاعد لتصبح عمليات، ونظم أبنية اجتماعية، تلك التي تحدث بين شخصين، أو في داخل الجماعة الصغيرة، وتشابهت نظرياتهم في ذلك، كما ان نظرية التبادل التي قدمها «جورج هومانز» «George Humans» و«بيتر بلاو» «Peter Blau» نظرت إلى الذين يتبادلون قيما من خلال تفاعلاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية اليومية، وهذه القيم تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية، أنهم يمتلكون نوعا من الرشد( ).
والحياة الاجتماعية عامة في رأي مثل «جبريل تارد» «Gabriel Tard» وهو مؤسس اتجاه السلوكية الجمعية، والذي هو أقدم الاتجاهات في هذه المدرسة، تعتمد على تفاعل عاملين: «الاختراع، والتقليد»، فالاختراع وهو في جوهره ظاهرة فردية تضمن للمجتمع التجديد والتقدم، والتقليد يضمن للمجتمع الإستمرار، وقد كتب تارد «Tard» في كتابه قوانين التقليد «tradition law» إن المجتمع لا يستطيع أن يعيش ولا أن يتقدم إلى الأمام ولا أن يتطور دون أن يعتمد على ينبوع الروتين والتقليد الذي لا ينضب والذي يتزايد بإستمرار مع تعاقب الأجيال( ).
وأسهمت الدراسات الاجتماعية في دول العالم الثالث في الكشف عن مختلف أشكال القهر الاجتماعي، والثقافي الذي تعرضت لـه مجتمعات تلك الدول في حقبة الهيمنة الاستعمارية، مما أدى إلى تعزيز تخلفها الثقافي والتربوي ويمكن الإشارة هنا إلى كتاب فرانز فانون Franz Fanon»»» «معذبو الأرض» ودراسة ج. كابرال «J.kabral» السلطة والإيديولوجية «Power and Ideology»( ).
وقد بينت بعض الدراسات الصادرة في تلك المجتمعات مسؤولية الأنظمة المدرسية في عهود الاستعمارعن الأمية الواسعة التي خلفتها في تلك المجتمعات بعد استقلالها، وخاصة اقتصار تعليمها على نخب معينة كي تخدم في أجهزتها الإدارية، وكشف باولو فرايري «Paulo Freiri» زيف حملات محو الأمية الرسمية في مجتمعات أمريكا الجنوبية والطابع القهري لمضامين المقررات المعتمدة في تلك الحملات لمحو أمية الفقراء من سكان الأحياء الفقيرة في البرازيل، ودعا إلى «تعليم للكبار» قائم على توعية الدارسين في صفوف محو الأميةلمجتمعاتهم، والتخلص من هامشيتهم الاجتماعية ويتضمن كتابه «تربية المقهورين» «Pedagogy of the Oppressed» وكتاب «التربية من أجل الحرية» «Education for Freedom» إشارات واضحة لتمكين الأميين الكبار من التحرر من دونيتهم الاجتماعية والثقافية( ).
وفي بداية القرن العشرين ظهر ميل لتطوير الحقل المعرفى لهذا الفرع من علم الاجتماع العام نتيجة لتزايد أهمية التعليم، وانتشارمؤسساته في المجتمعات الحديثة، ونتيجة لذلك، ظهرت حتى عام 1914عدة مؤسسات، تقدم مواد تتعلق بعلم الاجتماع التربوي، وفي عام 1932 تم تأسيس، وتنظيم الجمعية الوطنية، لدراسة هذا العلم في بريطانيا، فقامت هذه الجمعية بنشر ثلاث نشرات سنوية بين عامى 1932- 1934، وتوقفت تلك النشرة عن الصدور بعد ذلك( ).
وقد لاحظ «هارنجتون» «Harington»، قلة عدد المواد، التي تدرس في مجال علم الاجتماع التربوي في الفترة بين عامي 1926- 1947، مما حدا به إلى الدعوة إلى الاهتمام بهذا العلم وموضوعاته وقضاياه ولقد أسهمت هذه البوادر الأولى في دفع عجلة قيام هذا العلم، الأمر الذي أدى إلى إزدهاره بعد نهاية الحرب العالمية الثانية( ).
وبالرجوع إلى كتابات بعض رواد علم الاجتماع الذين اهتموا بالتربية، نجد أنه في الخمسينيات من هذا القرن، بدأت تظهر في أوروبا وخاصة في انجلترا، دراسات تعالج التربية، من منظور علم الاجتماع، والذي أدى إلى فهم خطورة التربية في حياة المجتمع، والأفراد، والمواقف العقائدية الأيديولوجية حول وضع التربية، ومفاهيم مثل، تحقيق المساواة في فرص التعليم، إلى جذب علماء اجتماع جدد، لدراسة موضوع التربية، كظاهرة اجتماعية في إطارها الاجتماعي العام( ).
إن التربية الإسلامية على وجه الخصوص تهتم بالأخلاق، وتجعل منها الهدف الأسمى؛ لأنها تهدف إلى تكوين أناس ذوى نفوس أبية، وإرادة قوية، وعزيمة صادقة، يعرفون الواجب ويقومون به، وبالتالى يقرب المجتمع المسلم من الكمال الخلقي المنشود( ).
وذلك لأن الفكر التربوي الإسلامي يستمد أصوله النظرية والتطبيقية من منهجية تكوينية قيمية استلهمها من ينابيع القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة. وقد نجحت التربية الإسلامية في واقع الحياة على رقعة واسعة من الأرض، والمعمورة، وما تزال ينابيعها ثُرَّة خَيِّرة، يمكنها أن تجد التجربة الناجحة وتروى ظمأ الإنسانية، وتحل مشاكلها في كل زمان ومكان، وقد تجلت عناية التربية الإسلامية في تقديم العلم والحث على طلبه، وفي الاهتمام بالفضائل الخلقية والتخفيف من الآثار السلبية، لما قد يترتب على الفروق بين الشعوب والأجناس والطبقات في مجال التعليم، والدين، وإعطاء الأفراد فرصا متساوية في التحصيل، والتي لم تكتمل في كثير من الأمم الحديثة حتى اليوم( ).
فالطابع العام للتربية عند المسلمين لم يكن دينيا محضا، ولم يكن دنيويا محضا، وإنما كان يلائم بين الدين والدنيا مصداقا لقول الله تعالى: ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ [القصص: 77]، ويرى الفكرالإسلامي أن أمر الله تعالى: ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ [العلق: 1] هو البداية الصحيحة والطريقة المثلى، للتنمية الفكرية، والإعلاء من قيمة العقل والبحث العلمي، وتفعيلهما سلوكا حضاريا في واقع الحياة، وذلك لحماية الإنسان من التلوث الفكري، والبيئى، الذي يقضى على فاعليته وكرامته وعزته( ).
ولقد وهب كثير من العلماء حياتهم للعلم، تحصيلا وتدوينا، لا لشئ سوى الإيمان بتحصيل العلم، كما عبر عن ذلك الإمام الغزالي في الإحياء: «إذا نظرت إلى العلم، رأيته لذيذا في نفسه، فيكون مطلوبا لذاته، ووجدته سبيلا إلى الدار الآخرة وسعادتها، وذريعة إلى القرب من الله تعالى، ولا يتوصل إليه إلا به، وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمى السعادة الأبدية، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها، ولن يتوصل إليها، إلا بالعلم والعمل، فأصل السعادة في الدنيا والآخرة، هو العلم»( ).
ومن هنا تعتبر الدراسات التربوية في المجتمعات الإسلامية محورا مهما في أصول التربية الإسلامية، كما أن مثل هذه الدراسات تبرز أهمية دراسة علمائنا المسلمين، ومن العسير، أن نحيط في هذا المجال بالعدد الوفير من أصحاب النظرات التربوية، والمذاهب التعليمية عند المسلمين، مما أوجب علينا، التعرف على قطب كبير كان من أكبر أقطاب التربية وقادتها في العالم الإسلامي( ).
إنه أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ولد سنة (450هـ= 1058م) في الطابران (من أعمال خراسان). فيلسوف ومتصوف، رحل إلى بلدان متعددة، منها: بغداد، والحجاز، وبلاد الشام، ومصر، وأشهرمصنفاته: كتاب إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، والمنقذ من الضلال، وتوفي في بلدته سنة (505هـ= 1111م)( ).
قال ابن عساكر الدمشقي: «أنه أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي قال: أبو حامد الغزالي حجة الإسلام والمسلمين إمام أئمة الدين، من لم ترَ العيون مثله لسانا وبيانا ونطقا وخاطرا وذكاءً وطبعا، شذا طرفا في صباه بطوس من الفقه على الإمام أحمد الراذكاني، ثم قدم نيسابور إلى درس إمام الحرمين في طائفة من الشبان من طوس وجد واجتهد حتى تخرج عن مدة قريبة»( ).
وصار أنظر أهل زمانه في أيام إمام الحرمين «الجويني»، وبعد وفاته، «الجويني»، خرج من نيسابور، وصار إلى المعسكر، واحتل من مجلس نظام الملك محل القبول، وأقبل عليه الصاحب، لعلو درجته، وظهور اسمه وحسن مناظرته، وكان مجلسه محط رحال العلماء، ومقصد الأئمة، فكان للغزالي نصيب من الاحتكاك بالأئمة وملاقاة الخصوم اللد، ومناظرة الفحول وظهر اسمه في الآفاق، حتى أدت الحال به إلى أن رسم للمصير إلى بغداد، للقيام بالتدريس في المدرسة النظامية فصار إليها، وأعجب الكل بتدريسه، ومناظرته، وما لقى مثل نفسه، وصار بعد امامة خراسان، امام العراق وصنف في علم الأصول تصانيف، وجدد المذهب في الفقه، وفي الخلاف، وعلت حشمته ودرجته في بغداد، حتى كان تغلب حشمته الأكابر والأمراء ودار الخلافة، فانقلب الأمر من وجه آخر، وظهر عليه بعد مطالعة للعلوم الدقيقة( ).
وممارسة الكتب المصنفة فيها وسلك طريق التزهد وطرح ما نال من الدرجة والاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة، فخرج عما كان فيه، وقصد بيت الله تعالى، ثم دخل الشام واقام في تلك الديار قريبا من عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظمةوأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إليها مثل (إحياء علوم الدين) والكتب المختصرة منها مثل الأربعين، وغيرها من الرسائل، ثم أخذ في مجاهدة النفس وتغييرالأخلاق وتحسين الشمائل وتهذيب المعاش، فانقلب شيطان الرعونة وطلب الرياسة والجاه والتخلق بالأخلاق الذميمة، إلى سكون النفس وكرم الأخلاق وهداية الخلق، ودعائهم إلى ما يعنيهم من أمر الآخرة، وتبغيض الدنيا، والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية، ثم عاد إلى وطنه، لازما بيته، مشتغلا بالتفكير( )، وحمل إلى نيسابور والأمر خافيا، وتأكد أنه لم يريد طلب الجاه، وكم جاء إليه ممن يشتغلون بالخلاف، فما تأثر به، ولا اشتغل بجواب الطاعنين».
ويقول ابن عساكر الدمشقي «لقد زرته مرارا وما كنت أحدث في نفسي مع ما عهدته في سالف الزمان عليه من الزعارة وايحاش الناس والنظر إليهم بعين الازدراء والاستخفاف بهم كبرا وخيلاء واعتزازا بما رزق من البسطة في النطق والخاطر والعبارة وطلب الجاه والعلو في المنزلة، انه صارعلى الضد وتصفى عن تلك الكدوات، وكنت أظنه متلفع بجلباب التكلف متنمس بما صار إليه، فتحققت بعدالسبر والتنقير أن الأمر على خلاف المظنون، وأن الرجل أفاق بعد الجنون، وحكى لنا في ليال كيفية أحواله من ابتداء ما ظهر له سلوك الكبر، وغلبت الحال عليه بعد تبحره في العلوم واستطالته على الكل بكلامه، والاستعداد الذي خصه الله به في تحصيل أنواع العلوم وتمكنه من البحث والنظر»( ). وفي الحقيقة، إننا لا ننشد إظهار هذا المصلح الكبير، والمفكر العظيم، وإلا، فلن تكفى المئات الأفضل من هذه الدراسة، ولكن ما أسهمه هذا العالم الجليل في مجال العلم أهله ليكون مصلحا اجتماعيا، ورائدا فيلسوفا وفقيها، وصوفيا، وأصوليا، ومربيا، يحكمه إطار محكم من العلم الوافر، والعقل الناضج، والبصيرة الواعية والفكر الراشد، فصارت له الريادة فيها جميعا، وأصبح واحدا من أعلام العرب الموسوعيين المعدودين( ).
غير أنه يبقى سؤال: لماذا الغزالي دون غيره من أجلاء العلماء المملوء تراثنا بهم؟
لم يكن غير أبى حامد الغزالي كمفكر إسلامي واجتماعي، وفيلسوف، وإمام مسلم يستطيع أن يجعل من قضية الأخلاق قضية عقائدية تمس المجتمع، وأن تكون في المقام الأول الأخلاق الدينية إطارا، ومذهبا هي دستور مجتمعنا الإسلامي. لأنه يتحقق في فكر الغزالي شرطا الإيمان، والعمل، ولا إنفصال بينهما في تركيبة الأخلاق الإسلامية، وذلك أنه في الفكر الإسلامي لابد وأن يكون الاعتقاد هو المنظم للسلوك، فليست الأخلاق مجرد سلوك، وإنما السلوك لابد أن يكون مسبوقا بالاعتقاد سواء في ذلك شعائر الدين أو قيم الأخلاق، ففى خلال فترة اعتزاله، وزهده صنف كتابه إحياء علوم الدين، والذي ابتدأ تأليفه في القدس وأتمه بدمشق، وهو يمثل تجربته التي عاشها في تلك الفترة، ويعتبر كتاب الإحياء أحد أهم كتبه على الإطلاق( ).
واتسم منهج الغزالي في التنشئة الاجتماعية بالوسطية، ووقف بآرائه ضد العصبية الدينية والأفكار التكفيرية، حيث أرجع إبتعاد الناس عن طريق الحق والتدين، إلى طريقة الدعوة، التي تبناها أشخاص، يزكون أنفسهم بإظهار فساد غيرهم، وكانت من حكمه الشهيرة في كتاب (إحياء علوم الدين) «إن إنتشار الكفر في العالم يحمل أوزاره متدينون بغَّضوا الله إلى خلقه بسوء صنعهم وسوء كلامهم»، ومن خلال هذه العبارة نستطيع أن نعرف أو نفهم أنه كان في زمن الإمام أفراد متعصبون لأسس الدعوة الإسلامية حتى أنهم بَغضهم الناس وبغضوا الدين لأجلهم»( ).
ويعد الغزالي بحق ظاهرة فكرية، تكاد تكون فريدة في الفكر الإسلامي، وعبقريته هي عبقرية الصدق الأخلاقي، والذي أكد على تربية الفرد في كتابه إحياء علوم الدين؛ لأن الفرد في نظره أساس المجتمع، وصلاح الفرد هو صلاح المجتمع، فالإمام الغزالي هو بحق أول من أقام بناءا أخلاقيا منهجيا في الأخلاق الإسلامية منذ نشأتها وهذا يرجع بالأساس إلى أن هذا المنهج مستمد من القرآن والسنة النبوية( )، وكانت كتبه، ومؤلفاته ومناقشاته، السم القاتل الذي سقاه لمن يريدون أن يضيعوا المجتمع الإسلامي، وفي عصرنا تزداد المادية ضراوة ويظهر الغزالي من جديد، بكتبه ومؤلفاته، لإيقاف ذلك الغزو المتعدد الجوانب ليعيد القافلة الإسلامية، بإذن الله إلى مسارها الصحيح، وهل هناك أصدق على تصدى الغزالي للمادية اليوم، من الإقبال المنقطع النظير، على مؤلفاته في عالمنا الإسلامي المعاصر، إما بالدراسة والتعليق من المؤلفين، وإما بالقراءة، برغم بعد المسافة الزمنية بيننا وبين الغزالي( )؟!
وهذا يرجع أيضا بالأساس إلى عقيدة الإسلام الذي هو لكل زمان ومكان ويمكن ملاحظة أن الغزالي قد لقب بحجته؛ لشدة فهمه لهذا الدين القيم، وهذا ما تفتقده مجتمعاتنا في كثير من علمائها، الفهم الصحيح، والإخلاص لله، ولدين الله . فالغزالي كان بإجماع علماء المسلمين من السنة أحد كبار أئمة الإسلام( ).
ودراسة فكره التربوي تعد تنقية لبعض الأصول الفكرية التربوية في تراثنا بما يتلاءم مع ظروف المجتمع وليس برغبة في تكرارماكتب عنهم، وهذه سمة من سمات أي مشتغل من المشتغلين بالعمل العلمي في أي مجال من مجالاته؛ ولأن الغزالي هوحجة الإسلام والمسلمين، إمام أئمة الدين. وترى الباحثة أن هنا سؤال يجب طرحه: لماذا عندما نعود إلى ما يتمتع به تراثنا (وخاصة من الفكر الإسلامي) من الثراء الفكري نتهم بالتخلف وحب العودة إلى الخلف، وعدم التجديد والإبداع، أم أنه غزوفكري اجتماعي نفسي، مقصود منه عدم دراسة أفكار ونظريات هؤلاء العلماء الأجلاء، لمعرفة مسبقة من أعداء تطورنا، بقدر هذه الأفكار؟
ويلاحظ أن الغرب يتمسك جيدا بتراثه الفكري والنظري، بل ويحاول فرضه بصورة أو بأخرى برغم ما يعتريه من انتقادات وعجزعن فهم نظم الحياة وأصلها، وافتقاده للنظرة الشاملة، ورغم ذلك ندرس نظرياته بصورة أساسية، ولم تقصد الباحثة هنا أن تمحق هذه النظريات، ولكن، ما أرادت قوله، أن مؤسس علم العمران هو: العلامة عبد الرحمن ابن خلدون العالم العربي الإسلامي، وقد قال (جومبلوفيتش) الذي يعد من آباء علماء الاجتماع في ألمانيا أن ابن خلدون يمكن أن يعد مفكرًا عصريًا بكل معنى الكلمة من وجوه عدة... إنه درس الحوادث الاجتماعية بعمق هادئ رزين، وأبدى آراء عميقة جدًا، ليس قبل «كونت» فحسب بل قبل «فيكو» أيضا كما قال: (استفانو تولوزيو) الإيطالي «ليس لأحد أن ينكرأن ابن خلدون اكتشف حقائق كثيرة في علم الاجتماع( ) وغيره من العلماء المسلمين كثر في الاصلاح الاجتماعي، والتربية، والتنشئة الاجتماعية، ونحن أولى بالتمسك بدراسة تراث علمائنا، وبوضع النظريات الشاملة للمجتمعات.
هذا وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى ستة فصول، تناولت الباحثة في الفصل الأول: قضية البحث، وأهمية الدراسة، وأهدافها، تساؤلات البحث، تعريف المفاهيم المستخدمة، ثم وضع الإطار التحليلي للبحث. والفصل الثاني: وقد اشتمل على: الدراسات السابقة وانقسمت إلى: دراسات عن إسهام الإمام أبو حامد الغزالي في التربية، ودراسات عن التنشئة الاجتماعية، وموقع الدراسة الحالية على خريطة هذه الدراسات. والفصل الثالث، وقد اشتمل على: السياق الاجتماعي والثقافي للإمام أبو حامد الغزالي، حياته وما اشتمل عليه اجتماعيا وفكريا، ثم آراء بعض النقاد في الإمام، والفصل الرابع تحدث عن: علم الاجتماع التربوي ودراسة التنشئة الاجتماعية، وموقف النظريات الكلية، والجزئية فيهما، وموقف نظريات التربية أيضا من التنشئة الاجتماعية، وجاء الفصل الخامس وتحدث عن: الأهداف التربوية عند الغزالي، ومضامين التنشئة الاجتماعية في فكر الإمام، وقواعد وآليات التنشئة الاجتماعية عنده. والفصل السادس احتوى على: مناقشة النتائج في ضوء التساؤلات، ثموضع سياسة اجتماعية لإنجاز التنشئة الاجتماعية من وجهة الغزالي.
Other data
| Title | المتغيرات المحددة للتنشئة الاجتماعية في فكر «الإمام أبو حامد الغزالي» من منظور علم الاجتماع التربوي دراسة تحليلية سوسيولوجية | Other Titles | Specific variables of socialization in the thought «Imam Al- Ghazali» From the perspective of Educational Sociology Sociological analytical study | Authors | راقية محمد سمير سيد على النمر | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G10720.pdf | 899.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.