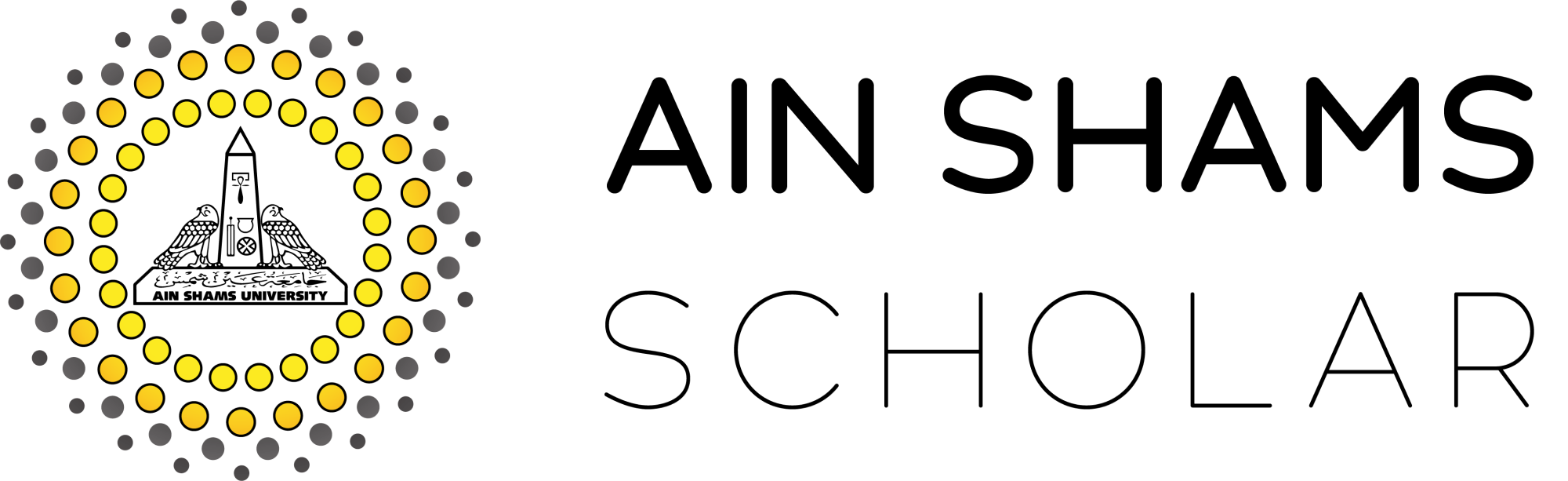صناعة مستقبل التعليم الجامعى (بين إرادة التغيير وإدارته)
صفاء احمد شحاتة;
Abstract
رحلة الإنسان والمؤسسات في صناعة التغيير وإدارته في المستقبل
الإنسان كائن حي يأكل، ويشرب، وينام، ويتحرك، ويتكاثر، ويعقل، وينطق، ويضحك كغيره من الكائنات، ولكن هناك صفتان تميزانه عن سائر الكائنات الأخرى . وهما صفتان جعلتا منه الكائن الوحيد، الذي له القدرة على السيطرة على حياته، وحياة سائر الموجودات من حوله.
الصفة الأولى: هي الوعي بالتاريخ، لكن المسألة ليست مجرد أن يكون للإنسان تاريخ، فهناك تاريخ للنبات، وتاريخ للحيوان ...، إلخ . ولكن الصفة الفارقة بين الإنسان، وغيره، أنه الكائن الوحيد، الذي يعي تاريخه . وهذا معناه أن كل جيل من البشر يعرف تجارب الجيل، الذي سبقه ويستفيد من تجاربه، ويضيف إلى اكتشافاته . وأنه بهذه الميزة وحدها، يجيء يومه أكثر تقدماً من أمسه، ويجيء غده أكثر تطورا من يومه، من حيث المجرى البشري العام . وبالتالي فإن كل جيل لا يبدأ من جديد، ولكن يضيف على ما سبق، وهذا هو التقدم.
الصفة الثانية: التي يعبر بها عن تفرد الإنسان عن سائر الكائنات الأخرى هي القدرة على التعامل مع معطيات التغيير، وتصور المستقبل . فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعي كم، ونوعية التغيرات الحادثة، وسرعتها، التي تضطره إلى أن يكون في حالة ترقب وتوقع مستمرة، للاحتمالات التي يمكن أن يكون عليها الغد؛ ومن هنا تجيء قدرته على التخطيط للمستقبل نحو ما هو أفضل؛ وفقاً لإرادته الإنسانية.
وقد يعتقد البعض أن هناك من الحيوانات من يعقل، وإن كان العقل درجات ومستويات.وبالتالي قد نتوقع من بعض الحيوانات مستوى من القدرة على توقع الأحداث المستقبلية . ولكن القدرة على تصور بدائل مستقبلية متعددة، ودراسة شروطها وعواقبها، وكيفية تحقيقها، والتركيز على البدائل المرغوب فيها، بناء على محكات معينة، هي صفة يتفرد بها الإنسان وحده، فقد حباه الله بقدرة غير محدودة على الإبداع، والانتفاع بالمعارف المتراكمة المكتسبة عن الآباء، والأجداد، مما يجعل حياة البشر قابلة للتطور الحضاري باستمرار.
وعلى العكس من ذلك، الحيوان، فالحيوان منذ آلاف السنين لا يختلف عن سلالاته التي نراها اليوم، في الصفات والطباع، ونوع الحياة، وحتى مع افتراض حدوث بعض التغيرات في بعض سلالات الحيوانات نجد أنها راجعة للصدفة، وعامل الطفرة الوراثية.
وتتوقف قدرة الإنسان على رسم وتصور المستقبل على عدة عوامل قد يكون أهمها الوعي بالتاريخ وفهم الحاضر بمعنى الوعي بالمتغيرات المتلاحقة وكيفية تلاحقها وما تتضمنه من معارف ومعلومات. فالوعي بالتاريخ والفهم العميق للحاضر هو الأساس لبناء دراسات مستقبلية متطورة مستنيرة. فالعلاقة بين الوعي بالتاريخ، وتحليل الحاضر، وتصميم دراسات مستقبلية دقيقة علاقة عضوية، وظيفية، بمعنى أن المعرفة بالتاريخ ضرورة، لفهم متغيرات الحاضر، ورسم معالم التكيف، والتعامل مع متغيرات المستقبل. ولا شك أن الصورة الملائمة، التي يجب أن تتم بها دراسة المستقبلات البديلة يجب أن يتوافر لها عدد من المتطلبات، وأن يُتقى خلالها الوقوع في بعض المحاذير، وتحقيق هذا الهدف هو وظيفة الدراسات العلمية الدقيقة، سواء الوصفية المسحية منها، أو التحليلية التنبؤية منها.
أما عن رحلة المؤسسات في صناعة المؤسسات، فهناك العديد من الأدبيات، التي تدرس المؤسسات على أنها كيانات يمكنها التعلم والنمو والتنبؤ بمستقبلها، بل وصناعته، بل والتحكم فيه أيضا على أن يتوفر التعلم المؤسسي المستمر، وبشرط دراسة ماضي، وحاضر المؤسسة؛ لتعرف السلبيات، والإيجابيات، التي من شأنها تساعد في التخطيط الجيد للمستقبل، والتعامل مع التغيير بالجودة المطلوبة، ليصبح كل ما يأتي به المستقبل من تغييرات هو فرصة وليس تهديداً للمؤسسة التعليمية.
صناعة التغيير في المستقبل
التاريخ يمثل أحد الأبعاد الثلاثة للزمن في مفهومه العضوي، الماضي، والحاضر والمستقبل . فحاضر اليوم هو ماضي الغد، ومستقبل الأمس. على الرغم من أن التاريخ يعني كل شيء حدث في الماضي، بل هو الماضي نفسه أو بعبارة أدق ما نعرفه من هذا الماضي، إلا أنه لا ينتهي بالحاضر، وإنما هو يمتد بلا نهاية، ويتغير بغير حد؛ لأنه لما كان جانب كبير من الماضي موجودا في الحاضر، فإن قدراً كبيراً من الحاضر سيكون موجودا في المستقبل، بما في ذلك قدر غير قليل مما لم يتضح بعد. فالإنسان في حاضره ومستقبله، جزء من ماضيه . وما الحاضر، الذي نعيشه سوى نتاج لما تم من تفاعلات، وإنجازات حضارية في الماضي، وإن كل حالة من الحالات، التي تحدث في لحظة خاصة تكون نتاج حالات سابقة عليها.
وإذا كان المستقبل لابد أن يبنى ويتأثر بمعطيات الحاضر، إلا أن هذا الحاضر كما هو معروف وليد الماضي، والماضي هو الموضوع الأساسي للتاريخ. فإن المستقبل يرتبط بالماضي عن طريق الحاضر ارتباطا عضويا وظيفيا . فنحن عندما ندرس الماضي فإننا في الوقت نفسه ندرس الحاضر والمستقبل؛ لأننا إذا دققنا النظر تبين لنا أن لا شيء في الوجود يتلاشى ويضيع مع الزمن، ولا يوجد فاصل بين الماضي، والحاضر، والمستقبل.
إن " الحاضر يحمل دائما قدرا صغيرا أو كبيرا من الماضي كما يحمل حتما في الوقت نفسه قدرا من المستقبل، بل كلما زاد مقدار الماضي فيه تشكل فيه مستقبل متوقع حدوثه، فبين الاثنين إذن علاقة بحيث إنه إن كانت ذكرياتنا عن الماضي قصيرة المدى هزيلة ضئيلة فإن نوع المستقبل الذي نتوقع يكون غريبا هزيلا، وعلى العكس إن كانت الذكريات زكية وافرة متنوعة، فإن المتوقعات يغلب أن تكون كذلك تقريبا.
ولا يمكن لباحث مستقبلي أن يرسم صورة دقيقة للمستقبل دون التعرض لتحليل الحاضر؛ لأن المستقبل هو وليد الحاضر، بمعنى أن تبدأ الدراسات المستقبلية من دراسة الواقع بأساليب على درجة عالية من العلمية. أي أن المدخل التخطيطي للمستقبل لابد أن يقوم على تصور ما ينبغي أن يكون عليه المستقبل في ضوء ما هو واقع، أو كائن بالفعل؛ وذلك لأن معظم إن لم يكن كل المشكلات، التي تواجه حاضرنا هي غالبا تراكمات تكاثرت عبر، وخلال تجارب، وأحداث الماضي بعيدا، وقريبا؛ إذ بهذه الطريقة، يمكن لنا أن نقترح البدائل، والحلول المختلفة، لمعالجتها المعالجة الصحيحة القائمة على الأسلوب العلمي.
فالتنبؤ العلمي بما قد يصير عليه الإنسان، والمؤسسة مستقبلا إنما هو حصيلة ما توصل إليه العلماء، حتى وقتنا الراهن، وعليها نستطيع أن نبني توقعاتنا .. ولكي يصبح للتنبؤات معنى لابد أن نقدم لكل منها الأساس الذي تمخضت عنه البحوث العلمية الراهنة، وبهذا نزاوج بين الحقيقة والخيال، وغالبا ما يتحول الخيال إلى حقيقة قبل أن يمارسها في زماننا هذا، بل نترك هذا لأجيال المستقبل.
وعلى العكس من ذلك، التجارب التاريخية السابقة، التي اعتمدت فقط على التأمل الفلسفي والخيال الجامح لما يمكن أن يكون عليه الغد، فهم بذلك قد قطعوا صلتهم بالماضي؛ ولذلك جاءت محاولاتهم بعيدة عن الواقع وأقرب إلى الخيال . إذن، هناك، اتفاق على أن تحليل الواقع هو خطوة أولى لبدء البحث المستقبلي، وتحليل الواقع هو الوظيفة الأولى لعلم التاريخ، فكما ذكر من قبل الحاضر؛ هو وليد الماضي ونتاجه، والتاريخ هو الميدان، الذي يمكن أن يحلل معطيات الحاضر بكل دقة وعلمية . وفي هذا الصدد يرى سعد مرسي أن الإلمام بالعوامل المؤثرة على العملية التربوية كما كانت، وكما هي الآن وكما ستكون في المستقبل أمر حتمي إذا كان المسئولون عن التربية في مجتمع ما جادين بكل الإخلاص في تنشئة سليمة للأجيال الصاعدة.
التنبؤ بالتغييرات التعليمية في المستقبل
إن تمييز الأزمات المحتملة مستقبلا حتى يمكن تفاديها لهو أحد الوظائف المهمة للدراسات المستقبلية . والواقع أن الاستكشاف المنهجي لاحتمالات المستقبل يمكن أن يعمل جهاز إنذار مبكر لتوقع أزمات الغد . وهذه الوظيفة التنبؤية للدراسات المستقبلية توفر فرصاً مهمة لمعالجة المشكلات المختلفة، أو لإجراء تغيير في الرأي العام يتيح للسياسيين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة، التي كان يمكن لها، من قبل أن تثير السخط العام، أو العنف الشعبي.
وتعتبر الدراسات المستقبلية المتعلقة بالتعليم من أكثر مجالات الدراسات الاجتماعية رواجا في العالم الغربي في الوقت الحاضر. وتحاول الدراسات المستقبلية التربوية التنبؤ بمستقبل التعليم، واتجاهات نموه، والتغيرات ، التي يحتمل أن تطرأ عليه كما وكيفا .وبناء على ذلك يمكن استخلاص مثل هذه الأحكام العامة من التاريخ التربوي ويمكن التنبؤ في ضوئها:
• لا يمكنك أن تستحدث إصلاحاً تعليمياً دون أن تثير قوى معارضة، وتتناسب شدة المعارضة طردياً مع مدى هذا الإصلاح، ذلك أن هناك دائماً مصالح مرتبطة بالوضع القائم المراد تغييره، أو إصلاحه.
• لا يمكن أن تتحقق ثورة تعليمية ناجحة إلا إذا كانت الطبقة الحاكمة قد أيدت وناصرت هذه الثورة.
• لا يمكن أن تحقق نجاحاً في تطوير عنصر من عناصر العملية التعليمية إلا إذا شمل التطوير باقي العناصر الأخرى.
• لا يمكن أن تحقق نجاحاً في تطبيق نظام تعليمي، إلا إذا توافرت شروط معينة، مثل التمويل الملائم، والفهم المجتمعي، وتأييد الإرادة السياسية، وغيرها من الشروط الضرورية، واللازمة، لنجاح، مثل هذا النظام.
• أن الإرادة السياسية عليها عبء كبير في تعديل، وتغيير الكثير من القيم، والاتجاهات السارية في المجتمع. وبدون تأييد الإرادة السياسية لأي تغيير يصبح من الصعب أن يتحقق.
• التجارب الواقعية الملموسة هي، التي تغير اتجاهات، وقيم الأفراد نحو قضية ما وليست الشعارات، والندوات، والإعلانات.
• أن تغيير الاتجاهات، والقيم، وتعديلها يحتاج إلى فترة زمنية تختلف من ظاهرة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر.
صورة المتعلم في المستقبل من متطلبات التغيير
إذا كانت الدراسات المستقبلية تهدف إلى استطلاع المستقبل، أو المستقبلات المرغوب فيها فهذا يعني ضرورة تحديد ما هو مرغوب فيه، والذي يستند بالضرورة إلى أفكار الناس عن معنى الحياة، المجتمع الجيد، وعن العدل، وغير ذلك من المفاهيم الأخلاقية والقيم الإنسانية . على سبيل المثال، من الموضوعات، التي تستأثر باهتمام كبير من الدراسات المستقبلية صورة متعلم المستقبل، وأساليب التعليم، والتعلم فيها . وبالطبع هذا تصور مستقبلي قائم على فلسفة للتربية تتفق، وطبيعة الفرد، الذي نخطط من أجل تعليمه، وتكوينه في المستقبل، من حيث عاداته، وقيمه، واتجاهاته، واحتياجاته . فإذا كان الإنسان هو موضوع العملية التربوية، فلابد عند تصميم أي دراسة مستقبلية للتعليم أن يكون القائم عليها على علم، ودراية بخصائص هذا المتعلم، والمجتمع، الذي يحيا فيه وبطرق التعامل معها في الحاضر والمستقبل. خاصة، وأن طبيعة الفرد غير متماثلة في العصور، والأماكن المختلفة، فلكلِّ عصر، ولكلِّ مجتمع خصائصه التعليمية المختلفة.
عملية صنع القرار التربوي في إطار التغيير
تهدف الدراسات المستقبلية إلى توفير الأطر المفيدة لصنع القرار والتخطيط، فليس ممكنا وضع الخطط والسياسات، واتخاذ القرارات بدون افتراضات أساسية، وإذا كانت هذه خاطئة فإن التخطيط يمكن أن يكون كارثيا. إن أعظم الخطط، المبنية على افتراضات خاطئة، تصبح مآسيَ، وتستطيع الدراسات المستقبلية توفير افتراضات حكيمة عما سيشبهه المستقبل، ويجب غالبا أن يعبر عن هذه الافتراضات ضمن دائرة الاحتمالات والإمكانات بدلا من دائرة الوثوق واليقين؛ ولكن يجب أن تتوافر لدى المخطط بعض أسس وضع الخطط، وربما يمكن أن ينبه إلى وجوب مراجعة الافتراضات مع تقدم العملية التخطيطية.
ولكي تستطيع الدراسات التربوية المستقبلية توفير افتراضات أساسية لابد أن يعي الباحث المستقبلي التاريخ الاجتماعي والتربوي لظاهرة ما؛ حتى يتفادى وضع افتراضات خاطئة. فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن الباحث المستقبلي بصدد وضع افتراض لتكوين المعلم الجامعي في المستقبل، فلابد أن يعي جيداً التاريخ الاجتماعي والتربوي للمعلم الجامعي، ومهنة التدريس الجامعي؛ وذلك لأن قضية تكوين معلم المستقبل الجامعي يجب ألا تعالج فقط من حيث البحث في كيفية تقديم إعداد تربوي وأكاديمي جيد. ويحتاج الباحث المستقبلي في دراسة موضوع مثل هذا إلى تغيير الكثير من القيم، والاتجاهات، التي أحاطت بالمهنة، والمعلم أكثر من محاولته تصور برنامج أكاديمي، أو تربوي لإعداده. وهنا تبرز أهمية الوعي بالتاريخ، ودراسة تطور مهنة التعليم، وتطور القيم والاتجاهات، التي أحاطت بالمهنة، والمعلم والتي أدت إلى ظهور صور غير مرغوب فيها؛ ولتفادي ظهور مثل هذه الصور ثانياً في المستقبل لابد من دراسة هذا التاريخ أولاً وتحليل الحاضر جيدا، حتى يمكن وضع افتراضات جيدة، وصحيحة، لتكوين معلم جيد يحظى بالاهتمام والتقدير من قبل الطلاب، وأولياء الأمور، والمسئولين، ونفسه قبل كل هؤلاء.
دراسة المستقبل في عالم سريع التغير
ترتكز الدراسات المستقبلية في مجملها على مبدأ مهم وهو: اعتبار التغير عملية متسارعة، بل بالغة التسارع، وأنه ينبغي لقيادة هذا التغير الجامح النظر في الظواهر، والأحداث بشكل كلي، فلا ينبغي أن ننظر إلى كل حادثة، أو ظاهرة بمعزل عن السياقات الكلية للنظم، التي تستوعبها، أو نتصورها غير متصلة بها، فالإنسان، والكون يكونان منظومة متداخلة متفاعلة يستحيل دراسة أي منهما دون الآخر، ودون تفهم كامل، وشامل لطبيعة المؤثرات المتبادلة، والمتداخلة، وهنا تتجلى وحدة الكون، ووحدة الحقيقة، وترابطها فكريا.
ولكي يستطيع الباحث المستقبلي أن يقدم صورة دقيقة، ومحكمة عن ظاهرة تربوية معينة في عالم المستقبل سريع التغير لابد أن يركز على مبدأ آخر مكمل للمبدأ السابق وهو: لقيادة هذا التغير المتسارع ينبغي النظر في جذور الظواهر، والأحداث التربوية بشكل تطوري، فلا ينبغي أن ننظر إلى الظاهرة كما لو أنها وليدة الحاضر، أو نتصورها غير متصلة بما قبلها من ظواهر وأحداث. وهنا تبرز وظيفة فلسفة التاريخ، التي تستطيع أن تقدم للباحث المستقبلي صورة كلية تطورية شاملة عن كيفية ظهور، وتطور، وتغير ظاهرة تربوية ما مما يجعله أكثر فهماً لهذه الظاهرة. ويترتب على هذا الفهم الجيد للظاهرة وضع تصور مستقبلي دقيق، ومحكم عن تطورها، وتفاعلها في عالم المستقبل سريع التغير.
فكرة الكتاب
تشير الأدبيات العالمية بوضوح، ومنذ عقود عديدة أن من سمات العصر، الذي نحيا فيه هو التغير المستمر، الذي تتزايد سرعته كل عام مع الثورات التكنولوجية، والمعرفية، التي يتسم بها مجتمع المعرفة، فالتغيير والتحول، والتجديد هي سمات أساسية يجب أن تفهمها المؤسسات وتتقن آليات حدوثها حتى يمكنها أن تتواءم معها، وفي نظرة عامة على المؤسسات الصناعية والتجارية نجدها سريعة التأثر، والاستجابة بتلك الصفات نتيجة طبيعة عملها كمؤسسة تجارية، أو منتجة، وإنما يختلف الأمر بالنسبة لمؤسسة التعليم الجامعي، التي تتواءم ببطء مع تلك التغيرات نتيجة سياساتها، التي تتبعها، ونتيجة طبيعتها، التي تمثل نوعاً من التحدي الكبير، أما ملاحقة التغير، والتحول، فالمنتج الأساسي في مؤسسات التعليم الجامعي هو إنسان ذو جدارات، ومعارف، ومفاهيم، وقيم يكتسبها طوال سنوات التعلم، والدراسة وبما أن تلك الجدارات متغيرة بتغير المعرفة، وآلياتها فإن مؤسسات التعليم الجامعي مضطرة إلى مواكبة هذا التغير، وتكمن المشكلة في الإجابة عن سؤال مؤداه: كيف يمكن لتلك المؤسسات أن تفعل ذلك مع التسليم بصعوبة هذا التكيف، وتعدد متطلباته؛ ولذلك كان ضروريا أن تتخلى سياسات المؤسسات عن الأفكار والممارسات التقليدية والأشكال الهرمية، والتي في الغالب تعيق عملية المواءمة مع التغيير، وأن تسعى إلى التمكين المؤسسي من خلال التحول إلى مؤسسات تعمل وفق سياسات خاصة تساعدها على مواكبة التغير المعرفي، والتكنولوجي والمهني.
وتتبلور قضية الكتاب الحالي حول فعالية مؤسسات التعليم الجامعي في تحقيق مخرجاتها سواء أكانت التعليمية، أو المجتمعية، أو البحثية، وعلاقة تلك المخرجات بما يتوقعه المتعلم، وسوق العمل والمجتمع بصفة عامة، وفي هذا الصدد تشير العديد من الدراسات، والتقارير الرسمية إلى أن مخرجات المؤسسات التعليمية الجامعية لا تحقق المتوقع منها لبناء قدرة تنافسية بين نظائرها الإقليمية والعالمية، ومن المؤشرات المختلفة التي تشير إلى ذلك، والتي سوف نعرضها بالتفصيل لاحقا: لم تحظ المؤسسات المصرية بأي ترتيب في التصنيفات العالمية، ولا تستطيع المؤسسات الجامعية إتاحة فرص التعليم للراغبين، وتحقيق مستوى ضعيف ومحدود من رضا أصحاب الأعمال عن مستوى الخريجين، وغيرها من المؤشرات، ونرى أن من أهم العوامل، والأسباب وراء هذا المستوى غير المقبول من أداء مؤسسات التعليم الجامعي كونها مؤسسات لا تستطيع أن تتكيف مع التغيير، وأن تديره بما يحقق أهدافها المتنوعة، كذلك فهي لا تتسع لعمليات التمكين سواء للقيادات، أو للعاملين أو للمؤسسة ذاتها مما حولها إلى كيان جامد غير حي لا تتمتع بما يتمتع به الكائن البشري الحي من صفة القدرة على التكيف، والتغيير من خلال آليات التمكين المختلفة، ولذلك فهي تحافظ على مستوى من الثبات، وعدم التغيير لا يساعدها فقط على التوجه للمشاركة في بناء المستقبل، ولكن يساعدها وبكل قوة على التراجع إلى ظلمات الماضي؛ وتأسيسا على ذلك لا تتمكن المؤسسة الجامعية من التطوير المبدع، الذي يحقق أهداف المجتمع التنموية والمستدامة، أما المؤسسة، التي تستطيع أن تستخدم آليات العصر في التعامل مع معطياته ومتغيراته المتلاحقة، فيمكنها أن تتميز بما يلي:
• سياسات، وآليات، وفرص للتفكير الإبداعي، والمستقبلي، وتضع الخطط الكاملة لأقصى استفادة ممكنة في تحسين فعالية مخرجاتها، وفي تحسين علاقتها بسوق العمل، التي فقدتها في ظل الفلسفات، وسياسات التعليم، والتعلم والإدارة التقليدية.
• التوجه نحو تنمية قدرة المؤسسة قيادات، وأفراد على إدارة التغيير، واستثماره وتطويعه، ودفعه إلى الأمام بل، والمشاركة أيضا في تكوينه، وتشكيل معالمه، وبالتالي تتزايد قدرتها على التنبؤ به، تلك الصفة التي لم تستطع أن تكتسبها في ظل السياسات التعليمية، والإدارية التقليدية.
• ضمان تحسن مخرجاتها فهي مؤسسة يتم فيها التعليم والتعلم، والتقويم في أثناء العمل المؤسسي سواء أكاديمي، أو مالي، أو إداري، أو بحثي، أو مجتمعي؛ والعمل، وتتم جميع تلك العمليات من قبل المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس والقيادات في المؤسسة.
• تكوين رأس المال الاجتماعي الذي يحقق لها أعلى القيم البشرية التي يمكن أن تحسن من نوعية المخرجات وخاصة التعليمية والبحثية والمجتمعية والتي تتمثل في تنمية القيم، والمبادئ، والأخلاقيات، والعمل وفق معايير تحكم العلاقات المختلفة داخل وخارج المؤسسة والتي في النهاية تعمل على حماية المؤسسة ومخرجاتها والعاملين فيها من إساءة استخدام أي من مواردها أو مصادرها المتنوعة، فهي صمامات الأمان، التي تحكم طبيعة العمل في الشبكات الاجتماعية، والعمل الجماعي بين الأفراد والمؤسسات؛ لكي تحقق الأهداف، والمنفعة المجتمعية.
• شعور الأفراد العاملين والقيادات والطلاب وبل المجتمع ككل بالاطمئنان بأن هناك تطويراً حقيقياً سوف يحدث ووفق جدول زمني محدد يمكن اتباعه على عكس النظريات التقليدية في إدارة المؤسسات التي ترسخ لدى الفرد بأن الوضع دائما على ما هو عليه وأي تغيير تحدثه ما هو إلا تغيير جزئي لا يشعر به الأفراد. إن ممارسات مؤسسات المستقبل الممكنة ترى أن التغيير الشامل المستمر المبني على معلومات ومعارف وخطط واضحة هي الحل للعديد من مشكلات التعليم الجامعي.
• تحفيز وتشجيع المتعلمين والعاملين على اغتنام أقصى ما يوجد من فرص للإبداع في العمل والتطوير وإتاحة الفرصة للجميع لينفذوا مبادرات جديدة ومحسوبة إلى حد كبير، مؤمنين بأن المبادرة التي تتسم بالمخاطرة هي الفرص الحقيقة للتغيير والنمو والتطوير وضمان جودة مخرجات المؤسسة.
• تحقيق السعادة والشعور بها من قبل جميع الأفراد داخلها وخارجها باعتبار أن التعليم يمكِّن الأفراد من الكثير من الأشياء منها النجاح في العمل والحصول على التقدير والتعلم من الأخطاء والعمل وفق بيئة مترابطة متعاونة تسودها الأخلاقيات، وتلك كلها من عوامل شعور الفرد بالسعادة، وكم من المتعلمين الآن يرون في نموذج مؤسسات التعليم الجامعي الحالية خبرة غير سعيدة لا يودون استكمالها.
• كفاءة وفعالية أكبر وتحقيق درجة أعلى من رضا المتعلمين والمجتمع بصفة عامة وسوق العمل بصفة خاصة، وتحقق متطلبات التنمية المستدامة من خلال تحقيق مستوى أفضل من الجودة والنوعية والإنتاجية، وتكون مكاناً وبيئة أفضل للعمل، إنها مؤسسات أفضل وأجود للعملاء والمستثمرين.
• الاستفادة من المفاهيم والآليات الحديثة التي أثرت المجال التعليمي ومنها مفاهيم الجودة الشاملة، والهندرة، وإدارة التغيير ورأس المال المعرفي وغيرها، إن مؤسسة التعلم هي الشكل المناسب بل والأمثل لتحقيق متطلبات وتنفيذ تلك المفاهيم والسياسات الجديدة وتحقيق إمكانات نجاحها والتي على رأسها القوى البشرية التي هي القلب من فلسفة مؤسسة التعلم، لما تتيحه للأفراد من معارف وجدارات وقيم، كما أنها توفر لهم المتطلباته المتنوعة والمعقدة والتي قد لا يسهل توفيرها في أي مؤسسة في شكلها التقليدي، ومن هنا جاء الاهتمام بمفهوم المنظمات المتعلمة على اعتبار أن هذه المفاهيم أو المبادرات لا تعمل بذاتها، وأن هناك أشياء أخرى مطلوبة.
الإنسان كائن حي يأكل، ويشرب، وينام، ويتحرك، ويتكاثر، ويعقل، وينطق، ويضحك كغيره من الكائنات، ولكن هناك صفتان تميزانه عن سائر الكائنات الأخرى . وهما صفتان جعلتا منه الكائن الوحيد، الذي له القدرة على السيطرة على حياته، وحياة سائر الموجودات من حوله.
الصفة الأولى: هي الوعي بالتاريخ، لكن المسألة ليست مجرد أن يكون للإنسان تاريخ، فهناك تاريخ للنبات، وتاريخ للحيوان ...، إلخ . ولكن الصفة الفارقة بين الإنسان، وغيره، أنه الكائن الوحيد، الذي يعي تاريخه . وهذا معناه أن كل جيل من البشر يعرف تجارب الجيل، الذي سبقه ويستفيد من تجاربه، ويضيف إلى اكتشافاته . وأنه بهذه الميزة وحدها، يجيء يومه أكثر تقدماً من أمسه، ويجيء غده أكثر تطورا من يومه، من حيث المجرى البشري العام . وبالتالي فإن كل جيل لا يبدأ من جديد، ولكن يضيف على ما سبق، وهذا هو التقدم.
الصفة الثانية: التي يعبر بها عن تفرد الإنسان عن سائر الكائنات الأخرى هي القدرة على التعامل مع معطيات التغيير، وتصور المستقبل . فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعي كم، ونوعية التغيرات الحادثة، وسرعتها، التي تضطره إلى أن يكون في حالة ترقب وتوقع مستمرة، للاحتمالات التي يمكن أن يكون عليها الغد؛ ومن هنا تجيء قدرته على التخطيط للمستقبل نحو ما هو أفضل؛ وفقاً لإرادته الإنسانية.
وقد يعتقد البعض أن هناك من الحيوانات من يعقل، وإن كان العقل درجات ومستويات.وبالتالي قد نتوقع من بعض الحيوانات مستوى من القدرة على توقع الأحداث المستقبلية . ولكن القدرة على تصور بدائل مستقبلية متعددة، ودراسة شروطها وعواقبها، وكيفية تحقيقها، والتركيز على البدائل المرغوب فيها، بناء على محكات معينة، هي صفة يتفرد بها الإنسان وحده، فقد حباه الله بقدرة غير محدودة على الإبداع، والانتفاع بالمعارف المتراكمة المكتسبة عن الآباء، والأجداد، مما يجعل حياة البشر قابلة للتطور الحضاري باستمرار.
وعلى العكس من ذلك، الحيوان، فالحيوان منذ آلاف السنين لا يختلف عن سلالاته التي نراها اليوم، في الصفات والطباع، ونوع الحياة، وحتى مع افتراض حدوث بعض التغيرات في بعض سلالات الحيوانات نجد أنها راجعة للصدفة، وعامل الطفرة الوراثية.
وتتوقف قدرة الإنسان على رسم وتصور المستقبل على عدة عوامل قد يكون أهمها الوعي بالتاريخ وفهم الحاضر بمعنى الوعي بالمتغيرات المتلاحقة وكيفية تلاحقها وما تتضمنه من معارف ومعلومات. فالوعي بالتاريخ والفهم العميق للحاضر هو الأساس لبناء دراسات مستقبلية متطورة مستنيرة. فالعلاقة بين الوعي بالتاريخ، وتحليل الحاضر، وتصميم دراسات مستقبلية دقيقة علاقة عضوية، وظيفية، بمعنى أن المعرفة بالتاريخ ضرورة، لفهم متغيرات الحاضر، ورسم معالم التكيف، والتعامل مع متغيرات المستقبل. ولا شك أن الصورة الملائمة، التي يجب أن تتم بها دراسة المستقبلات البديلة يجب أن يتوافر لها عدد من المتطلبات، وأن يُتقى خلالها الوقوع في بعض المحاذير، وتحقيق هذا الهدف هو وظيفة الدراسات العلمية الدقيقة، سواء الوصفية المسحية منها، أو التحليلية التنبؤية منها.
أما عن رحلة المؤسسات في صناعة المؤسسات، فهناك العديد من الأدبيات، التي تدرس المؤسسات على أنها كيانات يمكنها التعلم والنمو والتنبؤ بمستقبلها، بل وصناعته، بل والتحكم فيه أيضا على أن يتوفر التعلم المؤسسي المستمر، وبشرط دراسة ماضي، وحاضر المؤسسة؛ لتعرف السلبيات، والإيجابيات، التي من شأنها تساعد في التخطيط الجيد للمستقبل، والتعامل مع التغيير بالجودة المطلوبة، ليصبح كل ما يأتي به المستقبل من تغييرات هو فرصة وليس تهديداً للمؤسسة التعليمية.
صناعة التغيير في المستقبل
التاريخ يمثل أحد الأبعاد الثلاثة للزمن في مفهومه العضوي، الماضي، والحاضر والمستقبل . فحاضر اليوم هو ماضي الغد، ومستقبل الأمس. على الرغم من أن التاريخ يعني كل شيء حدث في الماضي، بل هو الماضي نفسه أو بعبارة أدق ما نعرفه من هذا الماضي، إلا أنه لا ينتهي بالحاضر، وإنما هو يمتد بلا نهاية، ويتغير بغير حد؛ لأنه لما كان جانب كبير من الماضي موجودا في الحاضر، فإن قدراً كبيراً من الحاضر سيكون موجودا في المستقبل، بما في ذلك قدر غير قليل مما لم يتضح بعد. فالإنسان في حاضره ومستقبله، جزء من ماضيه . وما الحاضر، الذي نعيشه سوى نتاج لما تم من تفاعلات، وإنجازات حضارية في الماضي، وإن كل حالة من الحالات، التي تحدث في لحظة خاصة تكون نتاج حالات سابقة عليها.
وإذا كان المستقبل لابد أن يبنى ويتأثر بمعطيات الحاضر، إلا أن هذا الحاضر كما هو معروف وليد الماضي، والماضي هو الموضوع الأساسي للتاريخ. فإن المستقبل يرتبط بالماضي عن طريق الحاضر ارتباطا عضويا وظيفيا . فنحن عندما ندرس الماضي فإننا في الوقت نفسه ندرس الحاضر والمستقبل؛ لأننا إذا دققنا النظر تبين لنا أن لا شيء في الوجود يتلاشى ويضيع مع الزمن، ولا يوجد فاصل بين الماضي، والحاضر، والمستقبل.
إن " الحاضر يحمل دائما قدرا صغيرا أو كبيرا من الماضي كما يحمل حتما في الوقت نفسه قدرا من المستقبل، بل كلما زاد مقدار الماضي فيه تشكل فيه مستقبل متوقع حدوثه، فبين الاثنين إذن علاقة بحيث إنه إن كانت ذكرياتنا عن الماضي قصيرة المدى هزيلة ضئيلة فإن نوع المستقبل الذي نتوقع يكون غريبا هزيلا، وعلى العكس إن كانت الذكريات زكية وافرة متنوعة، فإن المتوقعات يغلب أن تكون كذلك تقريبا.
ولا يمكن لباحث مستقبلي أن يرسم صورة دقيقة للمستقبل دون التعرض لتحليل الحاضر؛ لأن المستقبل هو وليد الحاضر، بمعنى أن تبدأ الدراسات المستقبلية من دراسة الواقع بأساليب على درجة عالية من العلمية. أي أن المدخل التخطيطي للمستقبل لابد أن يقوم على تصور ما ينبغي أن يكون عليه المستقبل في ضوء ما هو واقع، أو كائن بالفعل؛ وذلك لأن معظم إن لم يكن كل المشكلات، التي تواجه حاضرنا هي غالبا تراكمات تكاثرت عبر، وخلال تجارب، وأحداث الماضي بعيدا، وقريبا؛ إذ بهذه الطريقة، يمكن لنا أن نقترح البدائل، والحلول المختلفة، لمعالجتها المعالجة الصحيحة القائمة على الأسلوب العلمي.
فالتنبؤ العلمي بما قد يصير عليه الإنسان، والمؤسسة مستقبلا إنما هو حصيلة ما توصل إليه العلماء، حتى وقتنا الراهن، وعليها نستطيع أن نبني توقعاتنا .. ولكي يصبح للتنبؤات معنى لابد أن نقدم لكل منها الأساس الذي تمخضت عنه البحوث العلمية الراهنة، وبهذا نزاوج بين الحقيقة والخيال، وغالبا ما يتحول الخيال إلى حقيقة قبل أن يمارسها في زماننا هذا، بل نترك هذا لأجيال المستقبل.
وعلى العكس من ذلك، التجارب التاريخية السابقة، التي اعتمدت فقط على التأمل الفلسفي والخيال الجامح لما يمكن أن يكون عليه الغد، فهم بذلك قد قطعوا صلتهم بالماضي؛ ولذلك جاءت محاولاتهم بعيدة عن الواقع وأقرب إلى الخيال . إذن، هناك، اتفاق على أن تحليل الواقع هو خطوة أولى لبدء البحث المستقبلي، وتحليل الواقع هو الوظيفة الأولى لعلم التاريخ، فكما ذكر من قبل الحاضر؛ هو وليد الماضي ونتاجه، والتاريخ هو الميدان، الذي يمكن أن يحلل معطيات الحاضر بكل دقة وعلمية . وفي هذا الصدد يرى سعد مرسي أن الإلمام بالعوامل المؤثرة على العملية التربوية كما كانت، وكما هي الآن وكما ستكون في المستقبل أمر حتمي إذا كان المسئولون عن التربية في مجتمع ما جادين بكل الإخلاص في تنشئة سليمة للأجيال الصاعدة.
التنبؤ بالتغييرات التعليمية في المستقبل
إن تمييز الأزمات المحتملة مستقبلا حتى يمكن تفاديها لهو أحد الوظائف المهمة للدراسات المستقبلية . والواقع أن الاستكشاف المنهجي لاحتمالات المستقبل يمكن أن يعمل جهاز إنذار مبكر لتوقع أزمات الغد . وهذه الوظيفة التنبؤية للدراسات المستقبلية توفر فرصاً مهمة لمعالجة المشكلات المختلفة، أو لإجراء تغيير في الرأي العام يتيح للسياسيين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة، التي كان يمكن لها، من قبل أن تثير السخط العام، أو العنف الشعبي.
وتعتبر الدراسات المستقبلية المتعلقة بالتعليم من أكثر مجالات الدراسات الاجتماعية رواجا في العالم الغربي في الوقت الحاضر. وتحاول الدراسات المستقبلية التربوية التنبؤ بمستقبل التعليم، واتجاهات نموه، والتغيرات ، التي يحتمل أن تطرأ عليه كما وكيفا .وبناء على ذلك يمكن استخلاص مثل هذه الأحكام العامة من التاريخ التربوي ويمكن التنبؤ في ضوئها:
• لا يمكنك أن تستحدث إصلاحاً تعليمياً دون أن تثير قوى معارضة، وتتناسب شدة المعارضة طردياً مع مدى هذا الإصلاح، ذلك أن هناك دائماً مصالح مرتبطة بالوضع القائم المراد تغييره، أو إصلاحه.
• لا يمكن أن تتحقق ثورة تعليمية ناجحة إلا إذا كانت الطبقة الحاكمة قد أيدت وناصرت هذه الثورة.
• لا يمكن أن تحقق نجاحاً في تطوير عنصر من عناصر العملية التعليمية إلا إذا شمل التطوير باقي العناصر الأخرى.
• لا يمكن أن تحقق نجاحاً في تطبيق نظام تعليمي، إلا إذا توافرت شروط معينة، مثل التمويل الملائم، والفهم المجتمعي، وتأييد الإرادة السياسية، وغيرها من الشروط الضرورية، واللازمة، لنجاح، مثل هذا النظام.
• أن الإرادة السياسية عليها عبء كبير في تعديل، وتغيير الكثير من القيم، والاتجاهات السارية في المجتمع. وبدون تأييد الإرادة السياسية لأي تغيير يصبح من الصعب أن يتحقق.
• التجارب الواقعية الملموسة هي، التي تغير اتجاهات، وقيم الأفراد نحو قضية ما وليست الشعارات، والندوات، والإعلانات.
• أن تغيير الاتجاهات، والقيم، وتعديلها يحتاج إلى فترة زمنية تختلف من ظاهرة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر.
صورة المتعلم في المستقبل من متطلبات التغيير
إذا كانت الدراسات المستقبلية تهدف إلى استطلاع المستقبل، أو المستقبلات المرغوب فيها فهذا يعني ضرورة تحديد ما هو مرغوب فيه، والذي يستند بالضرورة إلى أفكار الناس عن معنى الحياة، المجتمع الجيد، وعن العدل، وغير ذلك من المفاهيم الأخلاقية والقيم الإنسانية . على سبيل المثال، من الموضوعات، التي تستأثر باهتمام كبير من الدراسات المستقبلية صورة متعلم المستقبل، وأساليب التعليم، والتعلم فيها . وبالطبع هذا تصور مستقبلي قائم على فلسفة للتربية تتفق، وطبيعة الفرد، الذي نخطط من أجل تعليمه، وتكوينه في المستقبل، من حيث عاداته، وقيمه، واتجاهاته، واحتياجاته . فإذا كان الإنسان هو موضوع العملية التربوية، فلابد عند تصميم أي دراسة مستقبلية للتعليم أن يكون القائم عليها على علم، ودراية بخصائص هذا المتعلم، والمجتمع، الذي يحيا فيه وبطرق التعامل معها في الحاضر والمستقبل. خاصة، وأن طبيعة الفرد غير متماثلة في العصور، والأماكن المختلفة، فلكلِّ عصر، ولكلِّ مجتمع خصائصه التعليمية المختلفة.
عملية صنع القرار التربوي في إطار التغيير
تهدف الدراسات المستقبلية إلى توفير الأطر المفيدة لصنع القرار والتخطيط، فليس ممكنا وضع الخطط والسياسات، واتخاذ القرارات بدون افتراضات أساسية، وإذا كانت هذه خاطئة فإن التخطيط يمكن أن يكون كارثيا. إن أعظم الخطط، المبنية على افتراضات خاطئة، تصبح مآسيَ، وتستطيع الدراسات المستقبلية توفير افتراضات حكيمة عما سيشبهه المستقبل، ويجب غالبا أن يعبر عن هذه الافتراضات ضمن دائرة الاحتمالات والإمكانات بدلا من دائرة الوثوق واليقين؛ ولكن يجب أن تتوافر لدى المخطط بعض أسس وضع الخطط، وربما يمكن أن ينبه إلى وجوب مراجعة الافتراضات مع تقدم العملية التخطيطية.
ولكي تستطيع الدراسات التربوية المستقبلية توفير افتراضات أساسية لابد أن يعي الباحث المستقبلي التاريخ الاجتماعي والتربوي لظاهرة ما؛ حتى يتفادى وضع افتراضات خاطئة. فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن الباحث المستقبلي بصدد وضع افتراض لتكوين المعلم الجامعي في المستقبل، فلابد أن يعي جيداً التاريخ الاجتماعي والتربوي للمعلم الجامعي، ومهنة التدريس الجامعي؛ وذلك لأن قضية تكوين معلم المستقبل الجامعي يجب ألا تعالج فقط من حيث البحث في كيفية تقديم إعداد تربوي وأكاديمي جيد. ويحتاج الباحث المستقبلي في دراسة موضوع مثل هذا إلى تغيير الكثير من القيم، والاتجاهات، التي أحاطت بالمهنة، والمعلم أكثر من محاولته تصور برنامج أكاديمي، أو تربوي لإعداده. وهنا تبرز أهمية الوعي بالتاريخ، ودراسة تطور مهنة التعليم، وتطور القيم والاتجاهات، التي أحاطت بالمهنة، والمعلم والتي أدت إلى ظهور صور غير مرغوب فيها؛ ولتفادي ظهور مثل هذه الصور ثانياً في المستقبل لابد من دراسة هذا التاريخ أولاً وتحليل الحاضر جيدا، حتى يمكن وضع افتراضات جيدة، وصحيحة، لتكوين معلم جيد يحظى بالاهتمام والتقدير من قبل الطلاب، وأولياء الأمور، والمسئولين، ونفسه قبل كل هؤلاء.
دراسة المستقبل في عالم سريع التغير
ترتكز الدراسات المستقبلية في مجملها على مبدأ مهم وهو: اعتبار التغير عملية متسارعة، بل بالغة التسارع، وأنه ينبغي لقيادة هذا التغير الجامح النظر في الظواهر، والأحداث بشكل كلي، فلا ينبغي أن ننظر إلى كل حادثة، أو ظاهرة بمعزل عن السياقات الكلية للنظم، التي تستوعبها، أو نتصورها غير متصلة بها، فالإنسان، والكون يكونان منظومة متداخلة متفاعلة يستحيل دراسة أي منهما دون الآخر، ودون تفهم كامل، وشامل لطبيعة المؤثرات المتبادلة، والمتداخلة، وهنا تتجلى وحدة الكون، ووحدة الحقيقة، وترابطها فكريا.
ولكي يستطيع الباحث المستقبلي أن يقدم صورة دقيقة، ومحكمة عن ظاهرة تربوية معينة في عالم المستقبل سريع التغير لابد أن يركز على مبدأ آخر مكمل للمبدأ السابق وهو: لقيادة هذا التغير المتسارع ينبغي النظر في جذور الظواهر، والأحداث التربوية بشكل تطوري، فلا ينبغي أن ننظر إلى الظاهرة كما لو أنها وليدة الحاضر، أو نتصورها غير متصلة بما قبلها من ظواهر وأحداث. وهنا تبرز وظيفة فلسفة التاريخ، التي تستطيع أن تقدم للباحث المستقبلي صورة كلية تطورية شاملة عن كيفية ظهور، وتطور، وتغير ظاهرة تربوية ما مما يجعله أكثر فهماً لهذه الظاهرة. ويترتب على هذا الفهم الجيد للظاهرة وضع تصور مستقبلي دقيق، ومحكم عن تطورها، وتفاعلها في عالم المستقبل سريع التغير.
فكرة الكتاب
تشير الأدبيات العالمية بوضوح، ومنذ عقود عديدة أن من سمات العصر، الذي نحيا فيه هو التغير المستمر، الذي تتزايد سرعته كل عام مع الثورات التكنولوجية، والمعرفية، التي يتسم بها مجتمع المعرفة، فالتغيير والتحول، والتجديد هي سمات أساسية يجب أن تفهمها المؤسسات وتتقن آليات حدوثها حتى يمكنها أن تتواءم معها، وفي نظرة عامة على المؤسسات الصناعية والتجارية نجدها سريعة التأثر، والاستجابة بتلك الصفات نتيجة طبيعة عملها كمؤسسة تجارية، أو منتجة، وإنما يختلف الأمر بالنسبة لمؤسسة التعليم الجامعي، التي تتواءم ببطء مع تلك التغيرات نتيجة سياساتها، التي تتبعها، ونتيجة طبيعتها، التي تمثل نوعاً من التحدي الكبير، أما ملاحقة التغير، والتحول، فالمنتج الأساسي في مؤسسات التعليم الجامعي هو إنسان ذو جدارات، ومعارف، ومفاهيم، وقيم يكتسبها طوال سنوات التعلم، والدراسة وبما أن تلك الجدارات متغيرة بتغير المعرفة، وآلياتها فإن مؤسسات التعليم الجامعي مضطرة إلى مواكبة هذا التغير، وتكمن المشكلة في الإجابة عن سؤال مؤداه: كيف يمكن لتلك المؤسسات أن تفعل ذلك مع التسليم بصعوبة هذا التكيف، وتعدد متطلباته؛ ولذلك كان ضروريا أن تتخلى سياسات المؤسسات عن الأفكار والممارسات التقليدية والأشكال الهرمية، والتي في الغالب تعيق عملية المواءمة مع التغيير، وأن تسعى إلى التمكين المؤسسي من خلال التحول إلى مؤسسات تعمل وفق سياسات خاصة تساعدها على مواكبة التغير المعرفي، والتكنولوجي والمهني.
وتتبلور قضية الكتاب الحالي حول فعالية مؤسسات التعليم الجامعي في تحقيق مخرجاتها سواء أكانت التعليمية، أو المجتمعية، أو البحثية، وعلاقة تلك المخرجات بما يتوقعه المتعلم، وسوق العمل والمجتمع بصفة عامة، وفي هذا الصدد تشير العديد من الدراسات، والتقارير الرسمية إلى أن مخرجات المؤسسات التعليمية الجامعية لا تحقق المتوقع منها لبناء قدرة تنافسية بين نظائرها الإقليمية والعالمية، ومن المؤشرات المختلفة التي تشير إلى ذلك، والتي سوف نعرضها بالتفصيل لاحقا: لم تحظ المؤسسات المصرية بأي ترتيب في التصنيفات العالمية، ولا تستطيع المؤسسات الجامعية إتاحة فرص التعليم للراغبين، وتحقيق مستوى ضعيف ومحدود من رضا أصحاب الأعمال عن مستوى الخريجين، وغيرها من المؤشرات، ونرى أن من أهم العوامل، والأسباب وراء هذا المستوى غير المقبول من أداء مؤسسات التعليم الجامعي كونها مؤسسات لا تستطيع أن تتكيف مع التغيير، وأن تديره بما يحقق أهدافها المتنوعة، كذلك فهي لا تتسع لعمليات التمكين سواء للقيادات، أو للعاملين أو للمؤسسة ذاتها مما حولها إلى كيان جامد غير حي لا تتمتع بما يتمتع به الكائن البشري الحي من صفة القدرة على التكيف، والتغيير من خلال آليات التمكين المختلفة، ولذلك فهي تحافظ على مستوى من الثبات، وعدم التغيير لا يساعدها فقط على التوجه للمشاركة في بناء المستقبل، ولكن يساعدها وبكل قوة على التراجع إلى ظلمات الماضي؛ وتأسيسا على ذلك لا تتمكن المؤسسة الجامعية من التطوير المبدع، الذي يحقق أهداف المجتمع التنموية والمستدامة، أما المؤسسة، التي تستطيع أن تستخدم آليات العصر في التعامل مع معطياته ومتغيراته المتلاحقة، فيمكنها أن تتميز بما يلي:
• سياسات، وآليات، وفرص للتفكير الإبداعي، والمستقبلي، وتضع الخطط الكاملة لأقصى استفادة ممكنة في تحسين فعالية مخرجاتها، وفي تحسين علاقتها بسوق العمل، التي فقدتها في ظل الفلسفات، وسياسات التعليم، والتعلم والإدارة التقليدية.
• التوجه نحو تنمية قدرة المؤسسة قيادات، وأفراد على إدارة التغيير، واستثماره وتطويعه، ودفعه إلى الأمام بل، والمشاركة أيضا في تكوينه، وتشكيل معالمه، وبالتالي تتزايد قدرتها على التنبؤ به، تلك الصفة التي لم تستطع أن تكتسبها في ظل السياسات التعليمية، والإدارية التقليدية.
• ضمان تحسن مخرجاتها فهي مؤسسة يتم فيها التعليم والتعلم، والتقويم في أثناء العمل المؤسسي سواء أكاديمي، أو مالي، أو إداري، أو بحثي، أو مجتمعي؛ والعمل، وتتم جميع تلك العمليات من قبل المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس والقيادات في المؤسسة.
• تكوين رأس المال الاجتماعي الذي يحقق لها أعلى القيم البشرية التي يمكن أن تحسن من نوعية المخرجات وخاصة التعليمية والبحثية والمجتمعية والتي تتمثل في تنمية القيم، والمبادئ، والأخلاقيات، والعمل وفق معايير تحكم العلاقات المختلفة داخل وخارج المؤسسة والتي في النهاية تعمل على حماية المؤسسة ومخرجاتها والعاملين فيها من إساءة استخدام أي من مواردها أو مصادرها المتنوعة، فهي صمامات الأمان، التي تحكم طبيعة العمل في الشبكات الاجتماعية، والعمل الجماعي بين الأفراد والمؤسسات؛ لكي تحقق الأهداف، والمنفعة المجتمعية.
• شعور الأفراد العاملين والقيادات والطلاب وبل المجتمع ككل بالاطمئنان بأن هناك تطويراً حقيقياً سوف يحدث ووفق جدول زمني محدد يمكن اتباعه على عكس النظريات التقليدية في إدارة المؤسسات التي ترسخ لدى الفرد بأن الوضع دائما على ما هو عليه وأي تغيير تحدثه ما هو إلا تغيير جزئي لا يشعر به الأفراد. إن ممارسات مؤسسات المستقبل الممكنة ترى أن التغيير الشامل المستمر المبني على معلومات ومعارف وخطط واضحة هي الحل للعديد من مشكلات التعليم الجامعي.
• تحفيز وتشجيع المتعلمين والعاملين على اغتنام أقصى ما يوجد من فرص للإبداع في العمل والتطوير وإتاحة الفرصة للجميع لينفذوا مبادرات جديدة ومحسوبة إلى حد كبير، مؤمنين بأن المبادرة التي تتسم بالمخاطرة هي الفرص الحقيقة للتغيير والنمو والتطوير وضمان جودة مخرجات المؤسسة.
• تحقيق السعادة والشعور بها من قبل جميع الأفراد داخلها وخارجها باعتبار أن التعليم يمكِّن الأفراد من الكثير من الأشياء منها النجاح في العمل والحصول على التقدير والتعلم من الأخطاء والعمل وفق بيئة مترابطة متعاونة تسودها الأخلاقيات، وتلك كلها من عوامل شعور الفرد بالسعادة، وكم من المتعلمين الآن يرون في نموذج مؤسسات التعليم الجامعي الحالية خبرة غير سعيدة لا يودون استكمالها.
• كفاءة وفعالية أكبر وتحقيق درجة أعلى من رضا المتعلمين والمجتمع بصفة عامة وسوق العمل بصفة خاصة، وتحقق متطلبات التنمية المستدامة من خلال تحقيق مستوى أفضل من الجودة والنوعية والإنتاجية، وتكون مكاناً وبيئة أفضل للعمل، إنها مؤسسات أفضل وأجود للعملاء والمستثمرين.
• الاستفادة من المفاهيم والآليات الحديثة التي أثرت المجال التعليمي ومنها مفاهيم الجودة الشاملة، والهندرة، وإدارة التغيير ورأس المال المعرفي وغيرها، إن مؤسسة التعلم هي الشكل المناسب بل والأمثل لتحقيق متطلبات وتنفيذ تلك المفاهيم والسياسات الجديدة وتحقيق إمكانات نجاحها والتي على رأسها القوى البشرية التي هي القلب من فلسفة مؤسسة التعلم، لما تتيحه للأفراد من معارف وجدارات وقيم، كما أنها توفر لهم المتطلباته المتنوعة والمعقدة والتي قد لا يسهل توفيرها في أي مؤسسة في شكلها التقليدي، ومن هنا جاء الاهتمام بمفهوم المنظمات المتعلمة على اعتبار أن هذه المفاهيم أو المبادرات لا تعمل بذاتها، وأن هناك أشياء أخرى مطلوبة.
Other data
| Title | صناعة مستقبل التعليم الجامعى (بين إرادة التغيير وإدارته) | Authors | صفاء احمد شحاتة | Keywords | مؤسسات التعلم;التعليم الجامعى;إدارة التغيير | Issue Date | 2014 | Publisher | دار الفكر العربى | Description | يهدف هذا الكتاب إلى: • الكشف عن التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الجامعي وتعرف أهم: مشكلاتها، وخصائصها، وتحليلها؛ من أجل التخطيط لتحقيق متطلبات تنميتها. • مناقشة: أسباب، ودواعي التغيير المؤسسي التي تفرض على مؤسسة التعليم الجامعي العديد من الالتزامات في خططها وعملياتها وآليات الإدارة والتنظيم. • التعرف على النماذج العالمية في إدارة التغيير وآليات التقليل من ثقافة المقاومة لكل ما هو جديد في المؤسسة التعليمية. • نشر فكرة التمكين المؤسسي (للقيادات وللعاملين وللمؤسسة ذاتها) ودورها في تحسين أداء المؤسسة وتميز مخرجاتها المتنوعة. • عرض لعدد من النماذج العالمية في التمكين المؤسسي لتوضيح المفهوم والخصائص والسمات. • الكشف عن دور رأس المال المعرفي في تحقيق القدرة التنافسية في مؤسسات التعليم الجامعي في ظل متطلبات مجتمع المعرفة. • التأكيد على ضرورة استخدام أحد نماذج التغيير عند بدء عمليات التحول انطلاقا من منهجية علمية سليمة. • تقديم عدد من النماذج والأدوات التي تستخدم على نطاق عالمي في تقييم أداء مؤسسات التعليم الجامعي المتميزة ومنها القياس المقارن والقيمة المضافة. • الكشف عن أهمية الثقافة المجتمعية والمؤسسية الداعمة للتغيير والتطوير المؤسسي في مقابل توفير رأس المال البشري والمادي والتنظيمي. • توضيح ومناقشة العلاقة بين معايير الجودة التعليمية في مؤسسات التعليم الجامعي ومداخل التحسين والتغيير المؤسسي. • التأكيد على أهمية استقلال المؤسسات الجامعية ماليا وإداريا وأكاديميا في إطار من الحرية الأكاديمية التي تساعد على إحداث عمليات التغيير المؤسسي وتحقيق أهدافه. • عرض مقترح للتخطيط لتحسين الجودة والتميز في مؤسسات التعليم الجامعي. |
ISBN | 1 – 2944- 10 – 977 – 978 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.